التقدم على الذات: الثقافة العامة عن علم المناعة والفلسفة
مقال: وورويك أندرسون
ترجمة عبد الوهاب عرفة
نشر المقال في إيزيس: مجلة مجتمع تاريخ العلم بتاريخ سبتمبر 2014.
وورويك أندرسون طبيب وشاعر ومؤرخ استرالي.
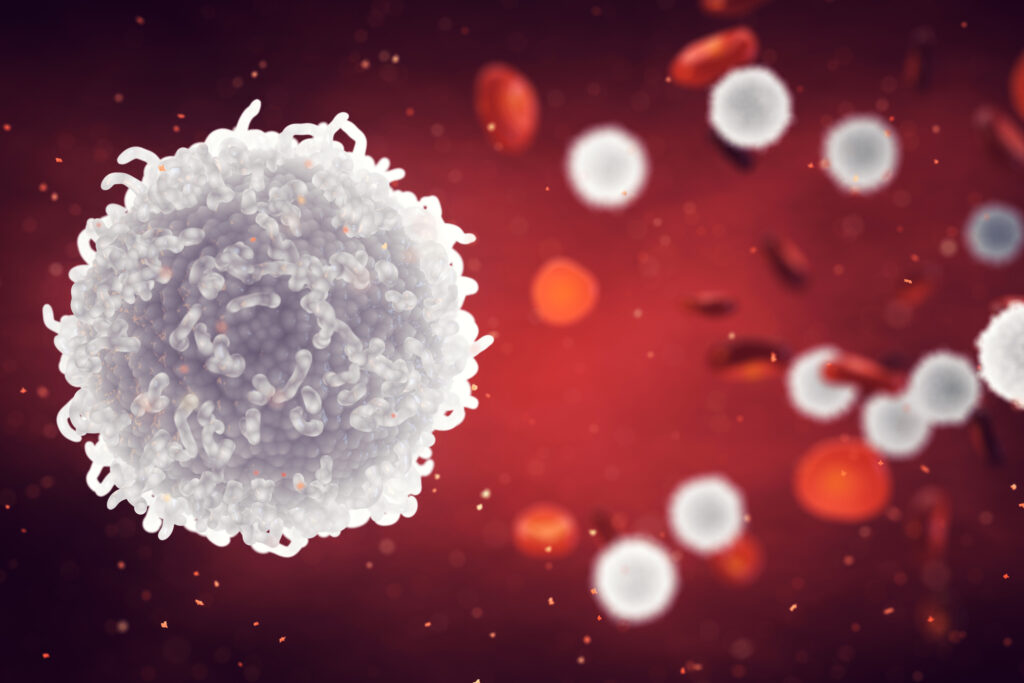
على مدار الثلاثين عامًا الماضية، باتت الاستعارات والنماذج والمفاهيم المستمدّة من علم المناعة تشكّل جزءًا كبيرًا من النظرية الاجتماعية والفلسفية. وقد استُخدم علم المناعة بشكلٍ متكرّر في إضفاء طابع طبيعي على أفكار الذات والهويّة والسيادة، وهو ما تجلّى بشكلٍ أوضح في أعمال "جاك دريدا" المتأخّرة. إلّا أنّ هذا "الطبيعي" الذي يمثّله علم المناعة في النقاشات الاجتماعية والفلسفية المعاصرة، هو في الواقع مستمَدّ من النظريات الاجتماعية والفلسفية التي سادت خلال فترة ما بين الحربين العالميتين وأثناء الحرب الباردة. فكلّ من علماء المناعة النظريين والمنظّرين الاجتماعيين كانوا يشاركون عن وعيٍ في ثقافة فكريّة واحدة. ومن ثمّ، فإنّ ما يُسمّى "المغالطة الطبيعية" في هذه الحالة يمكن إعادة صياغتها بوصفها خطأً في التصنيف، فالشرط الأساسي لإمكانية هذه المغالطة هو السعي الدائم لتطهير وفصل التصنيفات بين "الطبيعة" و"الثقافة". وعليه، فإنّ المشكلة -إن كان ثمة مشكلة- لا تكمن في اللجوء إلى الطبيعة بحدّ ذاتها، بل في افتراضنا أننا نملك مدخلًا خاصًّا وحصريًّا إلى مقولة مستقلة وذات سيادة تُدعى "الطبيعة".
في مستهل تأمّلاته حول مسيرته العلمية، قال العالِم الأسترالي "إف. ماكفارلين بورنت" عام 1965: "لطالما بدا لي علم المناعة أقرب إلى مسألة فلسفية منه إلى علم عملي". ولم تكن هذه العبارة مجرّد رأي عابر، بل تعبيرًا عن فهمٍ عميق تشكّل لديه عبر سنواتٍ من البحث في آليات الدفاع في الجسد، لا سيّما إنتاجه للأجسام المضادّة. وقد وجد توافقًا بين رؤيته هذه وما عبّر عنه "ألفرد نورث وايتهد" من تحذير بأنّ "العلم إن لم يتفلسف، فسيتحوّل إلى خليط من الفرضيّات المؤقّتة". وهكذا، انصهرت الفلسفة والنظرية الاجتماعية في علم المناعة عند "بورنت"، فعزّزت الأساس المعرفي لأبحاثه حول تسامح الذات -أي تعرّف الجسد على نفسه واحتفاظه بذاكرته عن ذاته- وهو ما أكسبه جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء¹ عام 1960. ولكن، ومنذ عهد "بورنت"، بدأ باحثو العلوم الإنسانية والاجتماعية يُدخلون الفلسفة والنظرية الاجتماعية في صلب علم المناعة نفسه. ففي أواخر القرن العشرين، وبوصفه علمًا يُعنى بما يُمكن تسميته "الذات"، قدّم علم المناعة مفردات غنيّة وإطارًا مفهوميًا جذّابًا للنقاش المتقدّم حول هوية الإنسان. وهكذا، استعاد مفهوم المناعة، بصورة ما، منبعه الأصلي، ليغدو في مطلع الألفية الجديدة مبدأً تنظيميًا ذا شأن، ومصدرًا وفيرًا للاستعارة في النظرية الاجتماعية.
وخلال الثلاثين عامًا الماضية تقريبًا، أصبح من الصعب على كثيرٍ من المفكّرين الغربيين التفكير في قضايا الحياة والموت دون استدعاء مفهوم الذات المناعية وما ينشأ عنها من "المناعة الذاتية الهدامة"، وهي الحالة التي يعجز فيها الجهاز المناعي عن التعرّف على الذات، فيهاجم أنسجة الجسد نفسه ويتسبّب في المرض. ومن هنا، منح الفيلسوف "جاك دريدا" لهذا النموذج المناعي "مدًى لا حدود له"، كما عبّر. فقد كان مفتونًا على نحو خاص بـ"اللاأقرارية" والتناقض الداخلي الكامن في العمليات المناعية الذاتية. إذ رآها تُفكّك -من داخلها- الأجسام السيّدة والهويات الآمرة، وتُظهر هشاشتها البنيوية. وفي عام 1996، كتب "دريدا" قائلًا: "نشعر أننا مخوّلون بالحديث عن منطق عام للتمنيع الذاتي... يبدو لنا أمرًا لا غنى عنه اليوم لفهم العلاقات بين الإيمان والمعرفة، والدين والعلم، بل وازدواجية المنابع بوجهٍ عام".² وعند نهاية القرن العشرين، تبنّى عددٌ من المنظّرين الاجتماعيين هذه الرؤية، وذهبوا إلى القول إنّنا -على المستويين الجسدي والاجتماعي- كائنات مناعية ذاتيًّا بطبيعتنا. وقد يُعد هذا الولع بالمناعة مثالًا لما لاحظه "لودفيغ فتغنشتاين حين قال إن "العمل في الفلسفة... هو نوع من العمل على الذات"، وإنّ معالجة المسألة الفلسفية "أشبه بمعالجة مرض".³
لكن، لعلّي أسبق الأحداث قليلًا. ففي هذه المساهمة ضمن مجموعة البحث هذه، أرغب في التوقّف عند نشأة ما يمكن تسميته "الميتافيزيقا المناعية" في أواخر القرن العشرين. غير أنّ تناول هذا المفهوم يستدعي، في الوقت نفسه، إلقاء نظرة على الجذور الفلسفية لعلم المناعة الحديث. ذلك أنّ ما أودّ اقتراحه هنا هو أنّ "مغالطةً سوسيولوجيّة" قد سبقت وأتاحت، في هذا السياق، "مغالطةً طبيعية"، أي أنّ الفكر الاجتماعي هو الذي منح الشرعية للعلم المناعي، بقدر ما تسعى العلوم الإنسانية والاجتماعية اليوم إلى إيجاد مشروعيّتها في أبحاث المناعة، وفي الطبيعي الذي سبق أن خضع للتشكيل الاجتماعي. ومن ثمّ، فإنّ ما يشغلني هو التبادل الكثيف والمعقّد بين النظرية الاجتماعية والعلوم البيولوجية. وهو تبادلٌ من شدّة تداخله وتشابكه قد يُخفي أحيانًا أيّ حدّ فاصل بين هذين الحقلين. بل لعلّ هذا هو جوهر ما أريد قوله. فالمفاهيم التي تستند إلى "العودة إلى الطبيعة" أو "الاحتماء بالثقافة" ليست سوى أوهام نفعية، تصوّرات من خيالٍ ثنائيّ ملائم. إذ تُخبرنا أسماء مثل "دونا هارواي" و"برونو لاتور" أنّ الطبيعة والثقافة متداخلتان إلى حدٍّ لا فكاك منه، مهما حاولنا جاهدين فصل إحداهما عن الأخرى. ولهذا، تبدو المصطلحات المختلطة كـ"السوسيولوجيا الحيوية"، و"الاجتماع الحيوي"، و"السياسة الحيوية"، أكثر قدرة على التعبير عن هذا التشابك البنيوي. فالمحاولة المستمرّة واليائسة دومًا لتقسيم هذا التراكم الفوضويّ إلى وحدات منفصلة، هي ما يُعرّفنا نحن "الحداثين"، أو هكذا يُقال. ومن هنا، ترى "لورين داستون" أنّ العودة إلى مفهوم "الطبيعة المستقلة" ليست سوى استراتيجية حديثة، شأنٌ خاصّ بالحداثة نفسها.⁴
ما أرمي إليه، في نهاية المطاف، هو أنّ الأفكار التي نجهد في تتبّعها من قطبٍ إلى آخر قد تكون في واقع الأمر تمارس اختلاطًا حرًّا وعشوائيًّا في بيئةٍ استوائيةٍ مشتركة تحت ظلال من النخيل. وعلى أن هذا التشبيه الجغرافي قد يبدو غريبًا أو حتى زائدًا عن الحاجة، فإن الفكرة التي يحملها ليست جديدة في تاريخ العلم. ففي مؤتمر عُقد عام 1957 بمدينة ماديسون في ولاية ويسكونسن -بعيدًا بكل أسف عن الأجواء الاستوائية- أوضح "جون سي. غرين" كيف أنّ مفكّري القرن التاسع عشر الاجتماعيين سعوا إلى استمداد "الشرعية العلمية لفلسفاتهم التاريخية"، مبيّنًا كيف أنّ "الأنبياء الاجتماعيين لبسوا عباءة العلماء"، أي أنّهم لجأوا بدورهم إلى الطبيعة طلبًا للمشروعية. وفي خاتمةٍ درامية، قال "غرين": "ومع ذلك، واصل العِلم مسيرته في طريقه الخاص، أمًّا خصبًا وقاسيًا، ولا يكفّ عن إنجاب نظريات علمية زائفة، ثم يتخلّى عنها كأنهم أبناء غير شرعيين". وهذا، في جوهره، هو مشهد الحداثة. ومع ذلك، فقد تساءل "ريتشارد إتش. شرايك"، في تعليقه على ورقة "غرين"، عمّا إذا كانت المفاهيم التطورية في البيولوجيا والمجتمع قد نشأت على نحو مستقل عن خلفيةٍ واحدةٍ مشتركة. وبالمثل، تأمّل "روبرت إم. يونغ"، في أواخر الستينيات، في هذا "السياق المشترك" بين النظرية البيولوجية والنظرية الاجتماعية، وأعرب عن أمله في تطوير منهجٍ يأخذ بالحسبان، بشكل منهجي، العوامل الاجتماعية والسياسية في البحث العلمي، والعوامل العلمية في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ⁵ورغم أنّ إشارته إلى "العوامل" المنفصلة قد تعكس انتماءً زمنيًّا لخطاب ستينيات القرن العشرين، فإنّ "يونغ"، في تقديري، كان يلمس شيئًا بالغ الأهمية، شيئًا يجعل ما يُسمّى "المغالطة الطبيعية"، أي الدعوة إلى طبيعة مستقلّة ومنفصلة عن المجتمع، ليست مغالطة بالمعنى الدقيق، بل أقرب إلى خطأ في التصنيف، أو لنقل: خطأ في منهجية التصنيف. ومع ذلك، فإنّ هذا الخطأ التصنيفي قد يُستخدم بشكلٍ استراتيجي -غالبًا من قِبل العلماء الطبيعيين، وأحيانًا من الاجتماعيين كذلك- لتعزيز حجّةٍ معيّنة، أو تبرير سياسةٍ ما.
لقد كانت كلمة "المناعة - الحصانة؛ (إذ إن الكلمة واحدة للاثنين بالانجليزية)" تُستخدم تقليديًّا للإشارة إلى الإعفاء من الالتزامات السياسية، فتميّز أفرادًا داخل المجتمع عن غيرهم. غير أنّها، في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت تُحيل إلى مجموعة من الوسائل البيولوجية التي يتّخذها الجسد للدفاع عن نفسه ضد الكائنات الممرِضة.⁶ ومنذ بداياته، اتّخذ علم المناعة بنيةً أقرب إلى السياسة الجماعية، بوصفه استراتيجيّة دفاعية ضد الغزو، أو عملية عسكرية بالمعنى المجازي. وهذه الحقيقة باتت معروفة إلى درجة أنّ إعادة سرد تفاصيلها هنا قد يكون فيه شيء من الإملال للقارئ. لكنّ اعتماد علم المناعة على النماذج والاستعارات العسكرية ليس سوى جانبٍ واحد من القصّة. إذ نشأ داخله تقليدٌ بديل، أخذ في التشكّل في أماكن مثل فيينا وباريس، وأكّد على جوانب التفاعل البشري والحساسية، وابتكر مصطلحات مثل "الحساسية" و"فرط التحسس الفوري".⁷ وقد انصبّ هذا التيار على الفردية البيولوجية والتفرّد، مُركّزًا، بلغة المناعة، على تفاوت شدّة الارتباط (avidity) بدلًا من التخصّصية الصارمة. وقد مهّد هذا التوجّه الذهني لتصوّر مفاهيم غير مألوفة، مثل "المناعة الذاتية"، حيث يضلّ الجهاز المناعي طريقه، فيهاجم ذات الجسد نفسه. و"المناعة الذاتية"، التي لم يُصَغ مصطلحها إلا في أواخر الخمسينيات، ليست في الحقيقة سوى "حساسية ذاتية" إن صحّ التعبير. فهي تنطوي على فشل في التعرّف على الذات وقبولها. ومنذ أربعينيات القرن العشرين، وبفضل "بورنت"، لم يعد علم المناعة محصورًا في دراسة وسائل الدفاع ضد الجراثيم، بل أصبح معنيًّا، بنفس القدر، بآليات تسامح الذات مع نفسها. لكن، ما أصل هذا "الذات المناعية" التي صارت في قلب كل هذا النقاش؟
كتب "بورنت" عام 1948 قائلًا: "جوهر المرض التحسّسي هو فرديّته". إذ استوقفته تلك الاستجابة المناعية المفرطة، بتفاعلاتها المبالغ فيها وحساسيتها الزائدة، وراح يتأمّل ما إذا كانت بعض الأمراض، مثل التصلّب المتعدّد، تنجم عن تحوّل الجسد إلى كيان يتحسّس من ذاته. وقال: "ما يحدث ببساطة هو أنّ عملية التنظيف العادية، التي يُتخلّص فيها من الخلايا التالفة، تنقلب لدى بعض الأفراد إلى عملية مناعية غير مناسبة، إذ يُنتَج جسمٌ مضادّ ضد مكوّن معيّن من خلايا عصبية تالفة، على سبيل المثال". ومع أنّ هذا الخطأ نادر الحدوث، فقد شغله السؤال: لماذا لا يحدث ذلك كثيرًا؟ وكلّما ازداد تأمّله، ازداد يقينه بأنّ "تمييز الذات عن اللاذات... هو على الأرجح أساس علم المناعة".⁸
وأودّ أن أتوقّف هنا، بإيجاز، عند سبب اختيار "بورنت" في نهاية المطاف لإعادة تأطير علم المناعة بوصفه علمًا للذات، لا لمجرّد الفردية. فعلى مدى سنوات، كان هذا العالِم المراقِب للطبيعة يُعجب بكتابات "جوليان هكسلي" المبسّطة، والتي ساعدته على التفكير بيولوجيًا، وزوّدته بحسّ مرهف تجاه مسألة الفردية البيولوجية.⁹ ومع ذلك، قرّر "بورنت" في أربعينيات القرن الماضي أن يُعلي شأن "الذات". ففي تلك الفترة، كان يقرأ تأمّلات "ألفرد نورث وايتهد" حول الذات ككِيان تجريبي ومتجسّد. وكان يُجِلّ "وايتهد"، بل ويعدُّه "أعظم فيلسوف على قيد الحياة". ولم يكن "بورنت" وحده في ذلك، إذ كان صديقه وزميله في علم الحيوان، "ولفريد إي. آغار"، مأخوذًا هو الآخر بفكر "وايتهد" المعقّد، وقد حاول أن يفسّره بيولوجيًا في كتابه "مساهمة في نظرية الكائن الحي - Contribution to the Theory of the Living Organism"، الذي قرأه "بورنت" أيضًا عام 1943. وكان ذلك ضمن دائرة بيولوجية صغيرة بجامعة ملبورن تضجّ آنذاك بنقاشات حول فلسفة "وايتهد". وقد وصف "آغار" الذات بأنها "وحدة من النشاط أو من العملية، ومكوّنات العملية أو عناصرها هي أحداث... ووحدة الذات هي كذلك وحدة من أحداث متعاقبة زمنيًا. فخصائص الذات في اللحظة الراهنة هي ثمرةٌ لمجمل تجاربها السابقة. أما نشاطات الكائن الحي، أو عملياته، فهي بمثابة ترابط من الأحداث". وقد بُني كتابه على فرضية مفادها أنّ الخلايا كائنات ذاتية الشعور، وأنّ الحيوان بأكمله كيانٌ ذاتي.¹⁰ وكما هو الحال لدى "وايتهد"، كان "آغار" يرى الذات في حالٍ من التشكّل المستمر والتغيّر والارتقاء؛ إذ إنّ طبيعة الذات أو الكينونة الفعلية هي أن "تُدرك" أو "تستشعر"، أن تتملّك البيانات من بيئتها لتُعيد بها تشكيل نفسها. ويمتلئ كتاب وايتهد العملية والواقع -Process and Reality -1929 بمفاهيم مثل "تجربة الذات" و"هوية الذات" و"خلق الذات" و"تشكّل الذات". وقد رأى في الذات "وحدة مركّبة... مقيّدة بنمط جوانبها". وقال: "ما يدوم هو هوية النمط، الموروثة ذاتيًا".¹¹ ويبدو أنّ "بورنت" قد استقى كثيرًا من هذه الفلسفة، وأدمجها في تفكيره المناعي.
وبما أنّ علم المناعة قد تحوّل، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى علمٍ يُعنى بالذات، فقد أصبح بالتالي مرتكزًا على الفلسفة العملية (process philosophy)، ومنخرطًا بلا تحفّظ في سوق الفلسفة الواسع. ومن هنا، إذا كان فلاسفتنا ومُنظّرونا الاجتماعيون المعاصرون يستندون إلى علم المناعة، فأيّ مغالطة طبيعية يمكن أن يُتَّهموا بها حقًا؟
وقد عبّر كثير من باحثي العلوم الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي عن شعورهم بالضيق من انشغالات الماضي، التي كانت تطرح مفهومًا للذات مفصولًا عن الجسد. إذ كانوا يبحثون عن بديلٍ متجسّد تمامًا، منظورٍ إليه من داخل الجسد لا خارجه. فقد اعتاد الفلاسفة، تقليديًّا، أن يربطوا الهوية الشخصية بالعقل؛ منذ زمن بعيد، أفرغ "جون لوك" الذات من الجسد، فاصطنع بذلك قطيعة بينها وبين المفاهيم اللاحقة للمناعة، التي تُعنى بصون سلامة الجسد وتماسكه.¹² وفي القرن العشرين، اتّجه الفلاسفة الماديّون إلى توطين الفردية الإنسانية داخل الدماغ، ذلك الإقليم الغامض الذي صار ميدانًا لعلم الأعصاب. وهكذا، انكمشت الذات لتعود وتسكن جزءًا واحدًا فقط من الجسد. وقد لاحظ مؤرّخو علم الأعصاب مرارًا هذا "الاختزال للذات إلى الوعي، بوصفه وظيفة للروح أو للدماغ".¹³ غير أنّ تأمّلات جديدة حول الجهاز المناعي، في أواخر القرن، فتحت أفقًا مختلفًا، إذ طرحت تصوّرًا لذاتٍ متجسّدة بالكامل، لجسدٍ سياسي، لكيان فرديّ بيوسياسي، أصبح متاحًا للمفكرين المنشغلين نقديًا بحالة الإنسان.¹⁴ فقد قال الفيلسوف الألماني "بيتر سلوتردايك": "بالنسبة لي، يجب ترجمة الميتافيزيقا العملية إلى لغة المناعة العامة، لأنّ الإنسان، بفعل انفتاحه على العالم، كائن شديد القابلية للتأثّر، من المستوى البيولوجي إلى المستويات القانونية والاجتماعية، وصولًا إلى المستويات الرمزية والطقسية... ومهمّة بناء أنظمة مناعية مقنعة هي مهمّة واسعة وشاملة إلى درجة لا تترك أي مجال لحنين الماضي".¹⁵
قالت "دونا هارواي" عام 1989 إنّ "الجهاز المناعي هو في آنٍ معًا كائنٌ رمزيّ أسطوريّ في ثقافة التكنولوجيا المتقدّمة، وموضوعٌ للبحث والممارسة السريرية في غاية الأهمية". وقد رأت أنّ علم المناعة الحديث يرسم خريطةً ترشد في التعرّف أو سوء التعرّف على الذات والآخر، ضمن جدليّة السياسات الحيوية الغربية. ومن هنا، فإنّ النصوص المناعية وتقارير الأبحاث التي نُشرت في ثمانينيات القرن العشرين كانت تُظهِر بجلاء أنّ "الجهاز المناعي هو بلا لبس كائنٌ ما بعد حداثي"، إذ يُمثّل نظامًا ترميزيًّا مشفَّرًا -أو حتى "مخادعًا مشفَّرًا"- يُستخدم للتعرّف على الذات والآخر. وقد تساءلت "دونا هارواي" عن الكيفية التي تعمل بها الفروقات بين الطبيعي والمرَضي، عندما يُعرَّف الجسد البيولوجي باعتباره "نصًّا مشفَّرًا، منظّمًا وفق نظام هندسي، تحكمه شبكة قيادة وتحكّم سائلة وموزَّعة". فبهذا المعنى، لم نعد نمتلك الجسد العضوي الهرمي الحديث؛ بل أصبح الجسد الآن منظومة من الرموز والتوزيعات والتشابيك، أي نظامًا سيميائيًّا متكاملًا. ومن هذا المنطلق، لاحظت "هارواي" أنّ "المرض هو نوع فرعي من خلل المعلومات أو علّة في الاتصال؛ إنّه عملية سوء تعرّف أو تجاوزٍ لحدود تجمّع استراتيجي يُسمّى الذات... والفردانية هي مشكلة دفاع استراتيجي". وبذلك، لم يعد الجسد، كما في النماذج المناعية الحداثية، ساحةً هرميةً للمعركة، بل تحوّل إلى "جسدٍ شبكيّ يتّسم بتعقيدٍ وتخصّص مذهلَيْن".¹⁶ ومن هنا، رأت "هارواي" ومَن تبعوها في علم المناعة مصدرًا لتصوّر جسدٍ ما بعد حداثيّ، جسدٍ يعيد بعث هوية الإنسان، ويخطّ دستورًا جديدًا للذات.
في تلك الفترة تقريبًا، رأت عالمة الأنثروبولوجيا "إميلي مارتن" أنّ "علم المناعة يُسهم في صياغة نوعٍ من الجماليّات أو البُنى لجسد الإنسان، تعكس بعض السمات الأساسية للتراكم المرن في الرأسمالية". ومن خلال استكشافها للصور السائدة في النقاشات العلمية والشعبية حول الجهاز المناعي، سعت "مارتن" إلى فهم نوع العالم الاجتماعي الذي كان علماء المناعة ينسجون خيوطه. فقد اعتقدت أنّ هذا العلم يُتقن إضفاء صفة "الطبيعي" على بعض البُنى الاجتماعية والافتراضات الثقافية. ففي الروايات الشائعة، لا يزال تشبيه المناعة بالحرب ضد عدوّ خارجي هو المهيمن؛ حيث يُشبه الجسد دولةً بوليسية، تحرس حدودها ضد المتسلّلين. وهنا، تصبح الحدود بين الذات والآخر جامدة ومطلقة. وتُسهم هذه الصور في جعل "التدمير العنيف يبدو مألوفًا، بل وضروريًّا ضمن مقتضيات الحياة اليومية".¹⁷ وفي المقابل، لاحظت "إميلي مارتن" أنّ علماء المناعة باتوا يميلون إلى تصوير الجسد باعتباره "نظامًا كليًّا متّصلًا، مكتفيًا بذاته"، أي كمنظومة "متوازنة ومنظّمة ذاتيًّا". ورأت أنّ النماذج القديمة ذات الطابع العسكري للجسد، والتي كانت "مبنيّة على مفاهيم القومية والحرب والجندر والعرق والطبقة"، باتت تتصارع مع تصوّرٍ جديد لجسدٍ مناعي "منظّم كنظام عالمي بلا حدود داخلية ويتّسم بسرعة الاستجابة ومرونتها." حيث بدا لها هذا الجسد الجديد وكأنه قد أُعيد تشكيله ليتناسب مع "الرأسمالية المتأخرة". وكانت "إميلي مارتن" على قناعة بأنّ علماء المناعة لا "يتجاهلون العالم خارج المختبر عند بلورة نماذجهم عن الجسد". ولهذا وثّقت كيف اصطدم خطاب المناعة اصطدامًا مباشرًا مع أوصاف الاقتصاد المعاصر في أواخر القرن العشرين، والذي تمحور حول التخصّص المرن والإنتاج المرن والاستجابة السريعة المرنة لسوق متغيّر باستمرار، بمنتجات مصمّمة خصيصًا حسب الطلب. ¹⁸
وقد ظلّت الأنثروبولوجيا الثقافية للمناعة مجالًا جاذبًا. فقد كتب أ. ديفيد نابير، "أنّ "الأفكار المناعية باتت تُشكّل اليوم الإطار المفهومي الأساسي الذي تتمّ ضمنه العلاقات الإنسانية في العالم المعاصر". وفي علم المناعة السائد، رأى هذا الأنثروبولوجي ما وصفه بـ"التزايد في استبطان الاختلاف داخل ذاتٍ يُفترض أنّها مستقلّة". وقد بدا له أنّ المناعة، عند مطلع القرن، تسهم في نفي الاختلاف، أو استيعابه، بل وتشارك في تجنّب تحوّل الذات. وكتب "نابير" أنّ "التعرّف على اللاذات وإقصاءها في علم المناعة يُجسّد، على المستوى الوجداني، نمط التباعد الإنساني الذي بتنا نعيشه ونتقبّله، للأسف". ومع ذلك، لم يكن مفهوم المناعة الذاتية مريحًا له؛ فقد كتب يقول: "كم تصبح معرفة الذات والتجربة الحسية معقّدتين، حين تُعبَّر عن التمييز بين 'الذات' و'اللا-ذات' ضمن العملية الجسدية المعروفة بالمناعة الذاتية". لقد حيّره هذا المفهوم، وأثار فيه شعورًا بعدم الاستقرار، إذ قال: "في المناعة الذاتية نقترب بوحشيّة من مرآة الغيريّة، إلى درجة لا تترك حيّزًا لأيّ تأمّل".¹⁹ وكان من الواضح أنّه لم يكن يعرف تمامًا كيف يتعامل مع هذا المفهوم.
وما لبث "نابير" أن عدّل دعوته المؤثّرة إلى تجسيد مناعي أكثر تحرّرًا وتسامحًا. ففي عام 2012، أشار إلى أنّ نظرية الانتقاء النسيلي التي قدّمها "بورنت" كانت تستند إلى فرضية "مرتبطة بالثقافة" مفادها وجود "ذات" مستقلة بالكامل، إلا أنّ هذه الهوية "السابقة والدائمة" لم تعد تحتلّ الموقع نفسه في علم المناعة. فقد بات علماء المناعة يعترفون بأنّ "الذات تتكوّن وتُعرَّف من خلال لقاءات محتملة الخطورة عند حدودها". بل إنّ الجهاز المناعي يبدو وكأنّه يستكشف الغيريّة بقدر ما يدافع عن الذات؛ فهو، في الحقيقة، منخرط في "محاولة إبداعية للتعامل مع الاختلاف"، لا القضاء عليه. فالأجسام المضادة، بحسب نابير، "تعمل كأنّها محركات بحث عن الذات، محركات بحث عن المعلومات (الضارّة أو النافعة) الكامنة في الفيروسات". وكما هو حال كثير من باحثي العلوم الإنسانية، اقتنع "نابير" بأنّ علم المناعة "ربما يكون في موقعٍ أفضل من أيّ مجال آخر في العلم الحديث... لمساعدتنا على إعادة التفكير في مفاهيم الذات التي هيمنت على الفلسفة الغربية على الأقل منذ عصر التنوير". وبوصفه إنسانيًّا، رأى أنّ الوقت قد حان "لإعادة النظر في إسهام علم المناعة في ميتافيزيقا الهوية".²⁰
أما "جاك دريدا"، الذي عُرف بممارسته لفن "التفكيك" وتعقيد الثنائيات المنطقية في الفلسفة التقليدية، وبقدرته على كشف كيف يمكن للآخر المُقصى أن يطارد حتى الكيانات التي يُظنّ أنّها خالصة أو "سليمة"، فقد اكتشف مفهوم المناعة الذاتية في أوائل التسعينيات. ففي "أطياف ماركس - Specters of Marx"، لاحظ الفيلسوف المتمرّد أنّ "الأنا، لكي تحمي حياتها، وتُشكّل نفسها كذاتٍ حيّة فريدة، وتعود إلى ذاتها بوصفها هي، لا بدّ أن ترحّب بالآخر في داخلها... فلا مفرّ لها من أن توجّه دفاعاتها المناعية، التي يُفترض أنّها مُعدّة ضد اللا-أنا، العدوّ، النقيض لها وخصمها، لتجعلها تعمل لصالحها وضدّها في الوقت نفسه". وبحسب "دريدا"، فإنّ "الأنا الحيّة مناعية ذاتيًّا - [le moi vivant est auto-immune]"، وقد أراد بذلك الإشارة إلى أنّ هناك عملية داخلية تُقوّض تماسك الشخص، وتُزعزع الهوية السيّدة وتُطيح بالسلطة، بينما تفتح في الوقت ذاته إمكانيات للمستقبل ولتحوّل الفرد. ولم يمر وقت طويل حتى أصبح "دريدا" مشغولًا بمنطق المناعة الذاتية، بصورة شبحٍ يطارد الذات. فلقد شعر بضرورة الإصغاء إلى الأشباح، وتساءل: "كيف يمكننا أن نُعيد إليها صوتها، حتى ولو كان ذلك في داخل أنفسنا، أو في الآخر، أو في الآخر الساكن فينا؟" أي، كيف نعترف بمنطق المناعة الذاتية ونُعبّر عنه؟²¹ وقد حيّر هذا المفهوم في بادئ الأمر كثيرًا من مُعجبيه، لكن سرعان ما استوعبوا هذا المجاز المناعي. فالبعض رأى في صورة المناعة الذاتية "رمزًا ذا قيمة فائضة كبيرة، يمكن توظيفه على الفور بشكلٍ مذهل، ويستمرّ في إشعاع دلالاته". وتساؤلهم كان: "هل التفكيك ذاته نوع من المناعة الذاتية؟" وقد ذهب أحد مترجمي "دريدا" إلى الإنجليزية إلى القول بأنّ المناعة الذاتية تُسمّي "عملية لا مفرّ منها ولا يمكن اختزالها، تعمل بدرجات متفاوتة في كلّ مكان تقريبًا، في صميم كلّ هوية سياديّة".²²
وقد اتّسم فهم "دريدا" لعلم أمراض المناعة الذاتية في بعض الأحيان بطابع غريب أو شاذّ. إذ كتب عام 1996: "أمّا عن عملية التمنيع الذاتي، التي تهمّنا هنا على وجه الخصوص، فهي تتكوّن، كما هو معروف وباختصار، من أن يقوم الكائن الحي بحماية نفسه من آليّته الذاتية للحماية، وذلك بتدمير جهازه المناعي الخاص".²³ ولعلّه كان يُفكّر آنذاك في التفسير المؤقّت لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، والذي اقترح -وهو ما تبيّن لاحقًا أنّه خاطئ- أنّ هناك عملية مناعية تدمّر الخلايا التائية في جسد المصاب.²⁴ ومع ذلك، بدا الفيلسوف متحمّسًا لتوسيع مجال النقد المناعي، إذ كتب: "ومع اتّساع ظاهرة هذه الأجسام المضادة لتشمل نطاقًا أوسع من الأمراض، ومع اللجوء المتزايد إلى فضائل الأدوية المثبطة للمناعة، التي تهدف إلى الحد من آلية الرفض وتسهيل تقبّل بعض عمليات زرع الأعضاء، نشعر أنّ من حقّنا الحديث عن منطق عام للتمنيع الذاتي". وأضاف: "فلا شيء مشترك ولا شيء منيع أو سالم أو مقدّس أو طاهر، لا شيء ينجو دون ملامسته خطر المناعة الذاتية، حتى في أكثر اللحظات الحيّة استقلالًا". فلقد رأى "دريدا" في المناعة الذاتية قوّة إيجابية، بقدر ما يمكن لغريزة الموت الفرويدية أن تحمل جانبًا من التأكيد والإثبات. فـ"الشهادة التي تُنازع ذاتها، هي التي تُبقي المجتمع المناعي حيًّا، أي منفتحًا على ما هو آخر، وما هو أكثر من ذاته: على الآخر، على المستقبل، على الموت، على الحرية، على قدوم الآخر، أو محبّته."²⁵ وبعبارة أخرى، فإنّ المناعة الذاتية تدفعنا إلى إعادة التفكير في مفهومي الحياة والموت.
وفي أواخر حياته، توسّع "دريدا" في تأمّله لما أسماه بـ"الورطة المزدوجة للمناعة الذاتية في الديمقراطية". فقد رأى أنّ المجتمعات السياسية، في سبيل حماية الديمقراطية أو إتاحة ديمقراطية مستقبلية، كثيرًا ما تُهاجم عناصر من الديمقراطية ذاتها، أو تُهيّئ الظروف التي تجعل هذا الهجوم ممكنًا، إما بإحالتها إلى مكانٍ آخر لحمايتها، أو بتأجيلها إلى وقتٍ لاحق، كما في تأجيل الانتخابات. وكان يُشير هنا إلى الظروف التي سبقت تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، وإلى ردّ فعل الحكومة الأمريكية على هذا الهجوم الذي استهدف سيادتها. وبالنسبة إلى "دريدا"، فإنّ هذه الأحداث تجلّت فيها منطقية مناعية ذاتية، تُشبه ما أسماه بـ"غريزة الموت" ضدّ الذات الديمقراطية. ومن هنا، فإنّ حتميّة وجود هذا "الآخر الكامن" في صلب الذات، وعدم القدرة على توقّعه أو احتوائه، يعنيان أنّه "لا يوجد إجراء وقائيّ مضمون تمامًا ضدّ المناعة الذاتية". بل ولا ينبغي أن يكون هناك مثل هذا الإجراء، فـ"المناعة الذاتية ليست شرًّا خالصًا أو مطلقًا. إذ تتيح لنا الانكشاف على الآخر، على ما ومن يأتي، وهذا يعني أنّه يجب أن تبقى غير قابلة للحساب. إذ إنه بدون المناعة الذاتية، وبتحصينٍ مطلق، لن يحدث أي شيء، ولن يصل أحد، ولن ننتظر أحدًا، ولن نتوقّع أي حدث". وهكذا، فإنّ مناعة الديمقراطية الذاتية أمرٌ مخيف وضروري في آنٍ معًا. فلم تكن المناعة الذاتية عند "دريدا" مجرّد أداة مفهومية للتفكير؛ بل كانت ضرورة حتمية، "اعتلالًا متعاليًا" لا فكاك منه.²⁶
ولقد شدّ علم المناعة كذلك اهتمام الفيلسوف الإيطالي "روبرتو إسبوزيتو". إذ يقول "إسبوزيتو" في عام 2006: "إنّ حقيقة أنّ عددًا من أبرز المفكّرين المعاصرين، الذين يعملون بشكلٍ مستقلّ عن بعضهم البعض، ويتبعون مسارات فكريّة مختلفة، قد اجتمعوا على الاشتغال على مفهوم "التحصين"، إنّما يدلّ بوضوح على أهمية هذا المفهوم في وقتنا الحاضر... فاليوم، الفلسفة التي تستطيع فهم زمنها (tempo) لا يمكنها تجنّب الاشتباك مع مسألة التحصين". بل إنّ مفهوم المناعة، بالنسبة لـ"إسبوزيتو"، هو الذي "يبتكر الحداثة بوصفها مجموعة من المفاهيم القادرة على حلّ مشكلة حماية الحياة". ففي السابق، كان علم المناعة مهووسًا بالدفاع العنيف ضدّ الغريب، وبالذات التي "تُصاغ كموجود مكاني محميّ بحدودٍ جينية صارمة"، أمّا الآن، "فالجسد يُفهَم بوصفه بناءً وظيفيًا منفتحًا على تبادلٍ دائم مع البيئة المحيطة به". ومن خلال قراءته لعلماء المناعة المعاصرين الأكثر اهتمامًا بالجانب الإدراكي، يؤكّد "إسبوزيتو" أنّ "الجهاز المناعي يجب تفسيره كغرفة صدى داخلية، كالحجاب الحاجز الذي من خلاله يعبرنا الاختلاف ويتفاعل معنا".²⁷ ويرى الفيلسوف أنّه ينبغي الاختيار بين التركيز إمّا على "التمرّد التدميري للمناعة على ذاتها"، أو الانفتاح على نقيضها: أي على الجماعة؛ أي بين المناعة الذاتية والتسامح. ومن قراءته لأحدث البحوث العلمية، يرى أنّ الجهاز المناعي "يعمل كسطحٍ عاكس أو كمرآة تعكس حضور العالَم داخل الذات"، ما يعني أنّ الذات حركيّة، وفي حالة تَشكُّل دائم. ومن خلال الذات فقط يمكن للمرء أن يتعرّف على الآخر، إذ يكتب: "لا شيء أكثر ارتباطًا بطبيعته بالتواصل من الجهاز المناعي".²⁸ وهكذا، يبدو علم المناعة في القرن الحادي والعشرين قادرًا على أن "يطبعِن" كلّ شيء.
لكن إلى أيّ مدى يمكن القول إنّ علم الذات "طبيعي" فعلًا؟ فالبيئة الثقافية المشتركة في فترة ما بين الحربين العالميتين ومتطلّبات الحرب الباردة هي التي شكّلت بشكلٍ جوهريّ "علم الذات"، بل وفي حالة "بورنت"، هي التي جعلته أساسًا "علمًا للذات". فهل يُنقص ذلك من طبيعيته أو علميّته شيئًا؟ بل ونجد أنّ علماء المناعة الأكثر تحفّظًا، وبعض فلاسفة العلم الذين يخشون تلوّث مجالهم بالاستعارات أو الشوائب الميتافيزيقية، يحاولون تنقية علم المناعة من مفهوم "الذات" الاستعاري أو الميتافيزيقي. فيكتب "ألفريد تاوبر"، عالم المناعة الذي تحوّل إلى فيلسوف علم: "إنّ تعريف الذات أصبح المهمّة الرئيسية لعلم المناعة، وهو اللغز النهائي الذي تسعى من خلاله هذه العلوم إلى تحديد ماهية الكائن الحي. لكن من أجل تحقيق هذا الهدف، استعار المجال مصطلحًا فلسفيًا ليعوّض لغةً هي بالأساس قاصرة عن أداء هذه المهمّة. وبهذا المعنى تحديدًا، تُستخدَم الذات استخدامًا مجازيًا." ويرى "تاوبر" أنّ اللجوء إلى مفهوم الذات يجعل علم المناعة مرتبطًا بفلسفة رديئة. فيقول: "ما بدأ كحدسٍ غامضٍ ومجازيّ حول كيف يمكن للمناعة أن تعمل كمشارك ضمن سياقٍ أوسع... سرعان ما طُمر تحت سيطرة الهاجس السائد بتعريف الذات المناعية بمصطلحات جزيئية".²⁹ ولهذا، فهو يدعو إلى تنقية لغة علم المناعة، والتخلّص من شوائبها المجازية، وإعادة العلم إلى طبيعته الحقيقية. ومن الواضح أنّ الذين يحرسون حدود العلم يرفضون حُجّة "ماري هيس" التي ترى أنّ اللغة كلّها مجازية، وأنّ التمييز بين ما هو حرفي وما هو مجازي تمييزٌ وهمي. وهم يرفضون كذلك تفسير "برونو لاتور" لنظرية "هيس"، حين قال إنّ العلم هو "بناء بطيء (ليس بناءً اجتماعيًا) لعلاقات شبه عائلية، لا ينفصل أبدًا انفصالًا جذريًا عن باقي المصادر والارتباطات الأخرى".³⁰
يشعر البعض أنّ تطهيرًا مشابهًا في النظرية الاجتماعية والفلسفة أصبح ضروريًا. فحتى في العشرينيات من القرن الماضي، أثار أسلوب "أوزفالد شبنغلر" المتصنِّع للعلم في كتابه "تدهور الغرب" غضب الروائي "روبرت موزيل"، الذي اعتبر أنّ استخدام "شبنغلر" السطحي للمفاهيم الرياضية والبيولوجية لم ينتج سوى رؤية فلسفية زائفة.³¹ ثم ازداد الغضب تجاه مثل هذه الادعاءات الفكرية الزائفة في نهاية القرن الماضي. ففي حادثة شهيرة، خدع "آلان سوكال" محرّري مجلّة "Social Text"، حين نشروا بسذاجة مقالته التي ادّعى فيها أنّ الجاذبية الكمومية تدعم مواقف ثقافية تقدمية. وقد أعلن "سوكال" بعد ذلك أنّ تقبّلهم السريع لهذه الخدعة يُثبت تفاهة البنائيّة الاجتماعية والنسبية الفلسفية في العلوم الإنسانية.³² وفي أواخر التسعينيات، بدا صوت المثقفين الرجعيين الذين ينتقدون هذه الادعاءات عاليًا جدًّا. فمثلًا، شنّ "جاك بوفريس" هجومًا حادًّا على الناشط والمنظّر الإعلامي "ريجيس دوبريه"، مستنكرًا استخدامه مبرهنة "كورت غودل" حول عدم الاكتمال (والتي تشير إلى أنّ الأنظمة المنظّمة لا تكتفي بذاتها وتحتاج إلى عناصر خارجية لإكمالها) بهدف تعزيز طرحه السياسي. وقد استلهم "بوفريس" أفكار "موزيل" و"فيتغنشتاين" في نقده لـ"دوبريه"، واتّهمه باللجوء الاستعراضي إلى العلم المعقّد لإخفاء هشاشة طروحاته، وقال إنّ "مبرهنة "جودل" لا تُعلّمنا في الواقع شيئًا على الإطلاق عن الأنظمة الاجتماعية".³³ وكان "دوبريه"، في نظره، يستعرض محاولًا إظهار براعته، لكنه بذلك كان يُشوّه العلم من أجل توضيح وجهة نظر اجتماعية مشكوك فيها.
وحتّى "دريدا" نفسه حذّر من أنّ مفهوم المناعة الذاتية "قد يبدو وكأنّه تعميم لنموذج بيولوجي أو فيزيولوجي دون أي حدود خارجية"، إلا أنّه سرعان ما رفض فكرة تنقية المصطلح، واستمرّ في استخدامه بكامل حرّيته.³⁴ ولمَ لا يفعل؟ فـ"دريدا"، مثل "هارواي" و"مارتن" و"سلوتردايك" و"إسبوزيتو" وآخرين كثر، كان يعرف أنّه يعمل ضمن سياق فكري مشترك. وفقط حين نحاول أن نؤسّس ونديم أنطولوجيا ثنائية القطبية، وحين نفرض رقابة على الحدود بين الطبيعة والمجتمع، نخلق الظروف الملائمة لظهور النزعة الطبيعية. وكما سيُشير "دريدا"، فإنّ منطق الثنائيات هذا خاطئ دائمًا. وبهذا المعنى، فإنّ المغالطة في "المغالطة الطبيعية" تكمن في محاولة تنقية التصنيفات بين الطبيعة والثقافة، ومنح السيادة لأحدهما على الآخر. وهذه هي بالضبط مغالطة الحداثيين. وكباحثين في تاريخ العلم، من الأفضل لنا أن نتبع خُطى علماء المناعة العمليين والفلاسفة المشاكسين، الذين يعملون على حلّ الغشاء الاصطناعي والهش الذي يفصل بين الطبيعي والاجتماعي، أو على الأقل، يفضحون مدى هشاشة ونفاذيّة هذا الغشاء. أي يمكننا أن نبيّن كيف أنّ الطبيعة والمجتمع كلاهما نتاجٌ لأخطاء في التصنيف وألاعيب خادعة، أو "ألعاب ثقة"، كما وصفتها "إيريكا ميلام".
الهوامش:
1. F. Macfarlane Burnet, “The Darwinian Approach to Immunity,” in Molecular and Cellular Basis of Antibody Formation, ed. J. Sterzl (New York: Academic, 1965), pp. 17–20, on p. 17; Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (1925; New York: Free Press, 1997), p. 17.
انظر أيضًا: Warwick Anderson and Ian R. Mackay, “Fashioning the Immunological Self: The Biological Individuality of F. Macfarlane Burnet,” Journal of the History of Biology, 2014, 47:147–175.
وانظر أيضًا: Burnet, Changing Patterns: An Atypical Autobiography (Melbourne: Heinemann, 1968); Christopher Sexton, The Seeds of Time: The Life of Sir Macfarlane Burnet (Oxford: Oxford Univ. Press, 1991).
2. Jacques Derrida, Rogues: Two Essays on Reason, trans. Pascale-Anne Brault and Michael Naas (Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 2005), p. 124; Derrida, “Faith and Knowledge: Two Sources of ‘Religion’ at the Limits of Reason Alone” (1996), in Religion, ed. Derrida and Gianni Vattimo (Cambridge: Polity, 1998), pp. 1–78, on p. 73n.
انظر أيضًا: Warwick Anderson and Ian R. Mackay, Intolerant Bodies: A Short History of Autoimmunity (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 2014).
3. Ludwig Wittgenstein, “Philosophy [from The Big Typescript, 1936],” in Ludwig Wittgenstein: Philosophical Occasions, 1912–1951, ed. J. C. Klagge and A. Nordman (Indianapolis: Hackett, 1993), pp. 158–199, on p. 161;
Wittgenstein, Philosophical Investigations, 2nd ed., trans. G. E. M. Anscombe (Oxford: Blackwell, 1958), p. 255.
ومن المرجّح أن فيتغنشتاين كان سيعتبر الفلسفة المناعية ضربًا من السحر، لا علاجًا.
4. Donna J. Haraway, “The Biopolitics of Postmodern Bodies: Constitutions of Self in Immune System Discourse,” in Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (New York: Routledge, 1991); Bruno Latour, We Have Never Been Modern, trans. Catherine Porter (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1993); Michel Serres, The Parasite, trans. L. R. Schehr (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1982); Lorraine Daston, “The Naturalistic Fallacy Is Modern,” in this Focus section.
انظر أيضًا: Erika Lorraine Milam, “A Field Study of Con Games,” in this Focus section.
5. John C. Greene, “Biology and Social Theory in the Nineteenth Century: Auguste Comte and Herbert Spencer,” in Critical Problems in the History of Science, ed. Marshall Claggett (Madison: Univ. Wisconsin Press, 1959), pp. 419–446, on p. 442; Richard H. Shryock, “Commentary,” ibid., pp. 447–453, on pp. 452–453; Robert M. Young, “Malthus and the Evolutionists: The Common Context of Biological and Social Theory” (1969), in Darwin's Metaphor: Nature's Place in Victorian Culture (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985), pp. 23–78, on p. 23.
6. Ed Cohen, A Body Worth Defending: Immunity, Biopolitics, and the Apotheosis of the Modern Body (Durham, N.C.: Duke Univ. Press, 2009).
7. Anderson and Mackay, Intolerant Bodies (انظر الحاشية رقم 2).
انظر أيضًا: Mark Jackson, Allergy: The History of a Modern Malady (London: Reaktion, 2006).
8. F. M. Burnet, “The Basis of Allergic Diseases,” Medical Journal of Australia, 1948, 1(2):29–35, ص 33، 29، 34، 30.
9. Julian Huxley, “The Biological Basis of Individuality,” Philosophy, 1926, 1:305–319، لا سيما ص 318، 310؛
وفي Essays of a Biologist (New York: Knopf, 1923)، يُشير هكسلي مرارًا إلى الفردية، مثلًا ص 108، 247.
10. Burnet, Changing Patterns (انظر الحاشية رقم 1)، ص 77؛. W. E. Agar, A Contribution to the Theory of the Living Organism (Melbourne: Melbourne Univ. Press with Oxford Univ. Press, 1943)، ص 8، 11 .من المحتمل أيضًا أن بورنت قرأ: Agar, “Whitehead's Philosophy of Organism: An Introduction for Biologists,” Quarterly Review of Biology, 1936, 11:16–34.
11. Alfred North Whitehead, Process and Reality: An Essay in Cosmology (1929), ed. D. Griffin and D. Sherborne, corrected ed. (New York: Free Press, 1978), ص 57، 85، 108، 187، 241.
12. John Locke, An Essay Concerning Human Understanding (1694)، ed. Peter H. Nidditch (Oxford: Clarendon, 1979).
ركّز لوك على قابلية الذات للانفصال والاستقلال.
13. Fernando Vidal, “Brains, Bodies, Selves, and Science: Anthropologies of Identity and the Resurrection of the Body,” Critical Inquiry, 2002, 28:930–974، ص 939.
14. Emily Martin, Flexible Bodies: Tracking Immunity in American Culture from the Days of Polio to the Age of AIDS (Boston: Beacon, 1994).
15. Erik Morse, “Something in the Air: Interview with Peter Sloterdijk,” Frieze, 2009, 129, www.frieze.com/issue/something_in_the_air (تمّ الدخول في 29 مارس 2013).
انظر أيضًا: Peter Sloterdijk, Sphären III: Plurale Sphärologie: Schäume (Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2004)؛ Sloterdijk and H.-J. Heinrichs, Die Sonne und der Tod (Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 2006).
16. Haraway, “Biopolitics of Postmodern Bodies” (انظر الحاشية رقم 4)، ص 205، 211، 207، 211، 212، 218.
17. Emily Martin, “The End of the Body?” American Ethnologist, 1989, 16:121–140، ص 126؛. Martin, “Toward an Anthropology of Immunology: The Body as a Nation State,” Medical Anthropology Quarterly, 1990, 4:410–426، ص 417.
18. Martin, “End of the Body?” ص 123، 129؛. Martin, Flexible Bodies (انظر الحاشية رقم 14)، ص 111، 93.
19. A. David Napier, The Age of Immunology: Conceiving a Future in an Alienating World (Chicago: Univ. Chicago Press, 2003)، ص 3، 11، 78، 79.
20. A. David Napier, “Nonself Help: How Immunology Might Reframe the Enlightenment,” Cultural Anthropology, 2012, 27:122–137، ص 125، 130، 132، 133، 132، 134.
21. Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International (1993)، trans. Peggy Kamuf (New York: Routledge, 1994)، ص 177، 221؛. Derrida, “‘Eating Well’; or, The Calculation of the Subject” (1991)، in Points…: Interviews, 1974–1994, ed. Elisabeth Weber, trans. Kamuf (Stanford: Stanford Univ. Press, 1995)، ص 255–286، على ص 285؛. Hans-Jörg Rheinberger, “Translating Derrida,” CR: The New Centennial Review, 2008, 8:175–187، ص 180.
22. W. J. T. Mitchell, “Picturing Terror: Derrida's Autoimmunity,” Critical Inquiry, 2007, 33:277–290، ص 281، 286؛. Michael Naas, “‘One Nation … Indivisible’: Jacques Derrida on the Autoimmunity of Democracy and the Sovereignty of God,” Research in Phenomenology, 2006, 36:15–44، ص 17.
23. Derrida, “Faith and Knowledge” (انظر الحاشية رقم 2)، ص 73n؛
انظر أيضًا: Derrida, “Autoimmunity: Real and Symbolic Suicides,” in Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida, ed. Giovanna Borradori (Chicago: Univ. Chicago Press, 2003), pp. 85–136, on p. 94.
24. John L. Ziegler and Daniel P. Stites, “Hypothesis: AIDS Is an Autoimmune Disease Directed at the Immune System and Triggered by a Lymphotropic Retrovirus,” Clinical Immunology and Immunopathology, 1986, 41:305–313؛ Ilana Löwy, “Immunology and AIDS: Explanations and Developing Instruments,” in Growing Explanations: Historical Perspectives on Recent Science, ed. M. Norton Wise (Durham, N.C.: Duke Univ. Press, 2004), pp. 222–247.
25. Derrida, “Faith and Knowledge” (انظر الحاشية رقم 2)، ص 73n، 47، 51؛
انظر أيضًا: Sigmund Freud, Beyond the Pleasure Principle, trans. C. J. M. Hubback (London: Hogarth, 1922).
26. Derrida, Rogues (انظر الحاشية رقم 2)، ص 39، 150–151، 152، 125.
توفي دريدا بمرض سرطان البنكرياس.
27. Roberto Esposito, in Timothy Campbell, “Interview: Roberto Esposito,” trans. Anna Papacone, Diacritics, 2006, 36:49–56، ص 53، 54؛
Esposito, Immunitas: The Protection and Negation of Life (2002)، trans. Zakiya Hanafi (Cambridge: Polity, 2011)، ص 159، 17، 18؛
Jean-Luc Nancy, Corpus, trans. Richard A. Rand (New York: Fordham Univ. Press, 2008)، ص 168.
28. Esposito, Immunitas، ص 141، 169، 174؛. Timothy Campbell, “‘Bios,’ Immunity, Life: The Thought of Roberto Esposito,” Diacritics, 2002, 36:2–22.
29. Alfred I. Tauber, The Immune Self: Theory or Metaphor? (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994)، ص 295؛
Tauber, “The Immune System and Its Ecology,” Philosophy of Science, 2008, 75:224–245، ص 226.
30. Bruno Latour, “Review of Michael A. Arbib and Mary B. Hesse, The Construction of Reality,” Isis, 1988, 79:135–137، ص 136؛
Mary Hesse, “The Explanatory Function of Metaphor,” in Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980)، ص 111–124؛. Hesse, “The Cognitive Claims of Metaphor,” Journal of Speculative Philosophy, 1988, 2:1–16؛ Evelyn Fox Keller, Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, Metaphors, and Machines (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2002)، ص 119، 146؛. George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By (Chicago: Univ. Chicago Press, 1980).
31. Robert Musil, “Mind and Experience: Notes for Readers Who Have Eluded the Decline of the West” (1921)، in Precision and Soul: Essays and Addresses, ed. and trans. Burton Pike and David S. Luft (Chicago: Univ. Chicago Press, 1990)، ص 134–149؛. Oswald Spengler, The Decline of the West (1918)، trans. Charles F. Atkinson (New York: Oxford Univ. Press, 1991).
انظر أيضًا: Warwick Anderson, “Waiting for Newton? From Hydraulic Societies to the Hydraulics of Globalization,” in Force, Movement, Intensity: The Newtonian Imagination and the Humanities and Social Sciences, ed. Ghassan Hage and Emma Kowal (Melbourne: Melbourne Univ. Press, 2011)، ص 128–135.
32. Alan Sokal, “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity,” Social Text, 1996, 46/47:217–252؛
Sokal and Jean Bricmont, Impostures intellectuelles (Paris: Jacob, 1997).
Bruno Latour, “Y a-t-il une science après la Guerre Froide?” Le Monde, 18 Jan. 1997؛ Latour, Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1999).
33. Jacques Bouveresse, Prodiges et vertiges de l'analogie: De l'abus des belles-lettres dans la pensée (Paris: Liber-Raisons d'Agir, 1999)، ص 27؛
انظر أيضًا: Bouveresse, “Why I Am So Very unFrench,” in Philosophy in France Today, ed. Alain Montefiore, trans. Kathleen McLaughlin (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983)، ص 9–33؛. Thomas Baldwin, “Jacques Bouveresse: Being unFrench, Metaphorically,” French Cultural Studies, 2007, 18:321–333؛ Régis Debray, “Savants contre docteurs,” Le Monde, 18 Mar. 1997 、 ص 1 、 17.
34. Derrida, Rogues (انظر الحاشية رقم 2)، ص 109.
