الافتراء على النفس جزء من إستراتيجية كافكا في صراعه الأبدي مع القانون.
جورجيو أجامبين: ك. (أو المكر الكافكاوي بالقانون)
“K.,” published in Giorgio Agamben, Nudities, trans. David Kishik and Stefan Pedatella (California: Stanford University Press, 2011), pp. 20–31.
ترجمه عن الإنجليزية: طارق عثمان. والعنوان الفرعي للمقال من وضع المترجم.
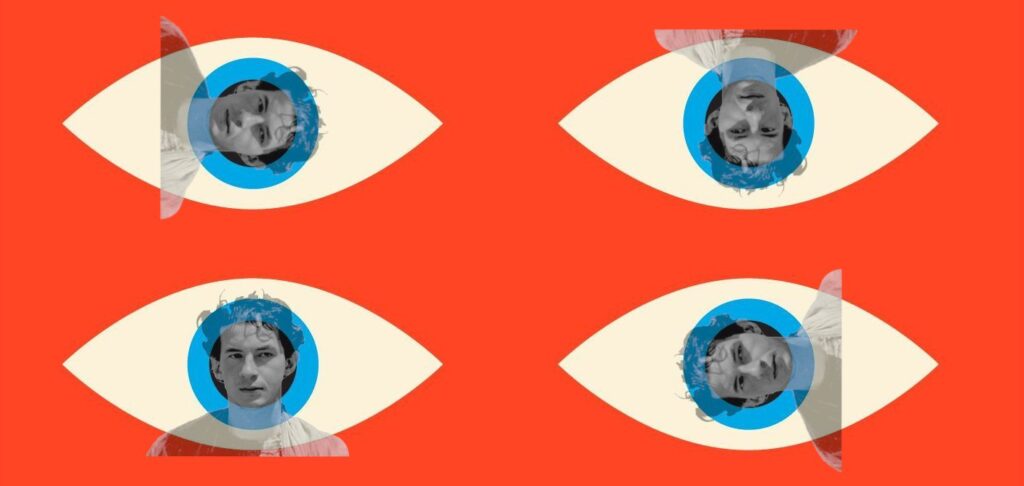
1.
في المحاكمات الرومانية، التي يلعب الادعاء العلني فيها دورا محدودًا، مَثّل الافتراء («Kalumnia» في اللاتينية القديمة) خطرًا بالغًا على إنفاذ العدالة، لدرجة أن من يتهم غيره بالباطل كان يُعاقب بوسم حرف ك (الحرف الأول من كلمة «Kalumniator»، مفتري) فوق جبينه. ويعود الفضل إلى دافيد ستيملي في توضيح أهمية هذه المعلومة في تأويل رواية المحاكمة لكافكا، التي تبين افتتاحيتها، وعلى نحو لا لبس فيه، أنها محاكمة افترائية، أي محاكمة قائمة على فرية: «لا بد أن أحدًا ما قد افترى على يوزيف ك.، لأنه اعتُقِل ذات صباح، من دون أن يرتكب أي جرم».[1] فلافتًا أنظارنا إلى أن كافكا قد درس تاريخ القانون الروماني أثناء تجهزه لممارسة مهنة المحاماة، يرى ستيملي أن حرف الكاف، في اسم يوزيف ك.، لا يرمز إلى كافكا –بحسب الرأي الشائع الذي يعود إلى ماكس برود[2]– وإنما إلى «Kalumnia»، أي افتراء أو فرية.[3]
2.
يمثل الافتراء إذن مفتاح هذه الرواية (وربما مفتاح عالم كافكا برمته، الذي يتمتع فيه القانون بقدرات أسطورية). لكن ستغدو هذه الفكرة أشد كشفًا لو اعتبرنا أن حرف الكاف، في اسم يوزيف ك، لا يرمز إلى «Kalumnia»، أو افتراء، ببساطة، وإنما إلى «Kalumniator»، أي مفترٍ، عوضًا عن ذلك. إذ سيعني ذلك لزامًا أن المفتري هنا هو بطل الرواية نفسه. أي أن البطل هو الذي أدخل نفسه في هذه المحاكمة الافترائية. إن الـ«أحدًا ما» الذي افتتح بفريته المحاكمة، هو يوزيف ك. نفسه وليس أي شخص آخر.
ومن شأن القراءة المتأنية للرواية أن تبين، وعلى نحو لا يتطرق إليه شك، أن هذا هو الحال حقًا. فعلى الرغم من أن ك يعلم منذ البداية أنه لا سبيل إلى التيقن من أن المحكمة قد اتهمته بالفعل («لا يمكنني أن أخبرك بأنك قد اتُّهِمت بأي شيء، أو حتى أتوخى الدقة، أنا لا أعرف ما إذا كنتَ اتُّهِمت أم لا»،[4] هكذا قال له المفتش في أول استجواب)، وعلى الرغم من أن وضعه «قيد الاعتقال» لم يقتض إدخال أي تغيير على حياته، إلا أنه قد سعى بكل سبيل ممكن إلى دخول مباني المحكمة (والتي ليست مباني محكمة حقًا وإنما عليّات، وغرف لتخزين المهملات، وغرف لغسل الملابس، لكن نظرته هي التي حولتها إلى قاعات محكمة ربما)، وإلى إقامة محاكمة لم يكن في نية القضاة إقامتها قط على ما يبدو. ليست هذه إذن محاكمة حقيقية وإنما هي محاكمة بقدر ما يعتبرها ك كذلك فحسب، وهذا أمر قد أقر به ك نفسه بقلق للقاضي في جلسة الاستجواب الأولى. ومع ذلك، لم يتردد في الذهاب إلى المحكمة من دون أن تنعقد ومن دون أن يُستدعى إليها، وهكذا أُذِن له بالدخول إليها من دون الحاجة إلى أن يُتهم. تمامًا كما لم يتردد، أثناء حديثه مع الآنسة بورستنر، في دفعها إلى اتهامه باطلًا بأنه قد اعتدى عليها (وبذلك افترى على نفسه، ولو على نحو غير مباشر).[5] وهذا هو تحديدًا ما أوضحه قس السجن لـك في نهاية حديثهما الطويل في الكاتدرائية بقوله: «إن المحكمة لا تريد منك شيئًا، إنها تأذن لك بالدخول عندما تأتي إليها، وتأذن لك بالإنصراف عندما تذهب عنها».[6] أو بعبارة أخرى: إن المحكمة لا تتهمك وإنما كل ما تفعله هو أنها تفتح ذراعيها للتهم التي تتهم أنت بها نفسك.
3.
يُدخِل كل إنسان نفسه في محاكمة افترائية. هذه هي المقدمة التي ينطلق منها كافكا. ولذلك لا يمكن لعالمه أن يكون تراجيديًّا، وإنما كوميديًّا محضًا: فالذنب غير موجود في عالم كافكا، أو بالأحرى، الذنب الوحيد الموجود هو الافتراء على النفس، اتهام المرء نفسه بارتكاب ذنب لم يرتكبه قط، أي اتهام المرء نفسه بكونه بريئًا. وهذه هي الإيماءة الكوميدية بامتياز (par excellence)، أي أن تكون البراءة هي التهمة.
ويتفق ذلك مع المبدأ الذي عبّر عنه كافكا في موضع آخر بقوله: «الخطيئة الأصلية، أقدم الخطايا التي ارتكبها الإنسان، هي ذلك الاتهام الذي يوجهه ولا ينقطع عن توجيهه قط: أن جرمًا قد ارتكب في حقه، أن خطيئةً أصليةً قد ارتُكبت في حقه».[7] وهنا أيضًا، وكما هو الشأن مع الافتراء، ليس الذنب هو سبب الاتهام، وإنما الذنب متطابق مع الاتهام، الذنب هو الاتهام.
والحق، أن الافتراء لا يمكن أن يكون افتراءً إلا إذا كان المتهِم على قناعة تامة ببراءة المتهَم، أي إلا إذا اتهمه بجرم لم يرتكبه. وفي حالة الافتراء على النفس، تغدو هذه القناعة ضرورية ومستحيلة في الوقت عينه: فالمتهِم نفسه بالباطل يعلم تمام العلم أنه بريء من هذه التهمة، لكنه يعلم تمام العلم أيضًا أنه مذنب وذنبه هو الافتراء، وبالتالي يعلم أنه يستحق أن يوسم جبينه بحرف الكاف. وهذا هو الوضع الكافكوي بامتياز (par excellence)؛ أن يكون المرء مذنبًا وبريئًا في الوقت عينه. لكن لماذا قد يفتري يوزيف ك (وكل إنسان آخر) على نفسه؟ ما الذي قد يدفعه إلى اتهام نفسه بالباطل؟
4.
اعتبر القضاة الرومان الافتراء اتهامًا منحرفًا، اتهامًا ضل سبيله (استخدموا في وصفه كلمة «temeritas» من «temere»، أي جزافًا أو «عميانيًا»، وهي ذات صلة تأثيلية بكلمة «tenebra» الإيطالية والتي تعني ظلمة. الافتراء هو اتهام دخل في الظلمة فضل سبيله). وقد لاحظ المؤرخ القانوني تيودور مومزين أن الفعل يتهم، «accusare» بالإيطالية، لم يكن مصطلحًا قانونيًّا في الأصل، وإنما نجده مستعملًا في أقدم الشواهد (في مسرحيات بلاوتوس وتيرينتيوس على سبيل المثال) بمعنى أخلاقي وليس قضائي. لكنه استقى أهميته القانونية الحاسمة تحديدًا من وظيفته كعتبة أمام القانون.
فالمحاكمة الرومانية تُفتتح بالـ«nominis delatio»، أي كتابة اسم المُدان، بطلب من المتهِم، في قائمة المتهَمين. فتأثيليًا، الفعل «accusare»، يتهم، مشتق من «causa»، أي «يكتب» (متهِمًا). وهكذا، يمكن اعتبار «causa»، يتهم، المصطلح القضائي الأساسي، لأنه يشير إلى إدخال شيء ما في نطاق القانون (كما أن كلمة «res» –شيء أو موضوع أو مسألة أو شأن، باللاتينية– تشير إلى إدراج شيء ما في نطاق اللغة)، أي إلى الأساس الذي يقوم عليه الموقف القضائي برمته. ومن هذا المنظور، تغدو العلاقة بين «causa» و«res» كاشفة. فكليهما ينتميان إلى المعجم القانوني، ويشيران إلى ما هو على المحك في المحاكمة أو في العلاقة القضائية (اتهام، وموضوع التقاضي، على التوالي). في اللغات المشتقة من اللاتينية، حلت «causa» بالتدريج في محل «res». لكن بعدما أضحت «causa» تُستعمل لتعيين المجهول في معادلات الجبر (كما أن «res» بقت حية في اللغة الفرنسية فقط من خلال كلمة «rien»، أي مجهول)، أخلت مكانها لكلمة «cosa» (في الفرنسية «chose»، أي شيء أو موضوع). وعليه، فهذه الكلمة المحايدة تمامًا والعامة للغاية، «cosa»، شيء أو موضوع أو مسألة، تشير، في الأصل، إلى شيء محددٍ تمامًا وخطير للغاية، إلى «محل النزاع»، «القضية»، أي إلى ما هو على المحك في القانون (وفي اللغة).[8]
وبناءً عليه، تعود خطورة الافتراء إلى كونه يزعزع الأساس الذي تقوم عليه المحاكمة، أي الاتهام. وذلك لأن ما يجعل المحاكمة محاكمة ليس الذنب (الذي لم يكن ضرورة في القانون العتيق)، ولا العقاب، وإنما الاتهام. فالاتهام هو المقولة (category) القضائية الأساسية (فالأصل اليوناني للكلمة، «kategoria»، يعني اتهام، أو خطبة اتهامية في العلن، حرفيًّا)، والتي من دونها سينهار صرح القانون، إذ بها، وبها وحدها، يُدخَل الإنسان في نطاق القانون. أي أن القانون ليس في جوهره سوى اتهام، أو مقولة («category»، بالمعنى اليوناني الأصلي للكلمة). وعندما يُدخَل الإنسان في نطاق القانون، أي عندما «يُتهم»، يفقد براءته، يصير «cosa»، أي موضوع للنزاع، قضية.[9]
5.
الافتراء على النفس جزء من إستراتيجية كافكا في صراعه الأبدي مع القانون. فأولًا، الافتراء على النفس يضع الذنب، أو حتى نتوخى الدقة، مبدأ لا عقاب من دون ذنب، في موضع الشك. وبالإضافة إلى تشكيكه في الذنب، يشكك الافتراء على النفس أيضا في الاتهام، بما أنه مبني على الذنب (ويمكن هنا أن نضيف غلطة أخرى إلى قائمة غلطات ماكس برود الفاحشة: كافكا غير مشغول بالفضل، أو بالعفو، كما يرى برود، وإنما بعكسه، أي بالاتهام). «كيف يمكن لأي شخص عامةً أن يكون مذنبًا؟!»، سأل يوزيف ك قس السجن، الذي اتفق معه، على ما يبدو، إذ رد عليه قائلًا إنه لا يوجد حكم في نهاية المحاكمة وإنما «تصير المحاكمة نفسها، تدريجيًا، هي الحكم، هي العقوبة».[10] وعلى نفس المنوال، قال أحد فقهاء القانون المعاصرين إن مبدأ لا عقوبة من دون حكم (nulla poena sine iudicio)، قد انقلب إلى مبدأ أشد ظلمة يقضي بأنه لا حكم من دون عقوبة، وذلك بما أن العقاب كله يكمن في الحكم نفسه.[11] و«في محاكمات كهذه، يكون المرء خاسرًا منذ البداية»، كما قال عم يوزيف ك في أحد مواضع الرواية.[12]
ويتجلى هذا المبدأ –أن المحاكمة نفسها هي الحكم، وهي العقوبة– في حالة الافتراء على النفس، وفي المحاكمات القائمة على الافتراء بعامة. فالمحاكمة الافترائية هي «case»، أو مقاضاة، من دون «cause»، أي قضية. وذلك لأن التهمة فيها هي الاتهام نفسه، بما أنه اتهام بالباطل، فرية. وعندما يكون الاتهام، أي ما يُدخل في المحاكمة، هو الذنب، لا بد أن تكون (مجريات) المحاكمة نفسها هي الحكم، هي العقوبة على هذا الذنب.
6.
بالإضافة إلى الافتراء، ميّز القضاة الرومان أمرين آخرين من شأنهما أن يفسدا الاتهام، أن يدخلاه في الظلمة، وهما: الـ«praevaricatio»، أي التواطؤ بين المتهِم والمتهَم (وهو نقيض الافتراء)، والـ«tergiversatio»، أي التراجع أو التنازل عن الاتهام (ماثل الرومان بين المحاكمة والحرب، وبالتالي اعتبروا أن التراجع عن الاتهام ضرب من الفرار من المعركة: فكلمة «tergiversare» تعني في الأصل «تولية الدبر»).
وهذه المفسدات الثلاث منطبقة كلها على حالة يوزيف ك: فأولًا، هو مفترٍ؛ وثانيًا، هذا الافتراء على نفسه، وبالتالي ثمة تواطؤ بين المتهِم والمتهَم بما أنهما نفس الشخص؛ وثالثًا، هو معترض على هذا الاتهام، وبالتالي متراجع عنه، إذ يتلكأ ويبحث عن مهرب.
7.
وهكذا يتبين للمرء مدى دهاء الافتراء على النفس كإستراتيجية ترمي إلى إبطال الاتهام وتعطيله. فعندما يكون الاتهام كاذبًا، وعندما يكون المتهِم هو المتهَم، يتقوض مبدأ الاتهام، أي ما يُدخل الإنسان في نطاق القانون. ومن هذا المنظور، يغدو السبيل الوحيد لتوكيد المرء على براءته أمام القانون (والقوى التي تمثله، كالأب والزواج على سبيل المثال) هو أن يتهم نفسه بالباطل.
ولقد نص ك. الآخر، بطل رواية القلعة، صراحةً، على أن الافتراء على النفس سلاح يمكن للمرء أن يدافع به عن نفسه في صراعه مع السلطة، لكنه «وسيلة دفاع بريئة إلى حد ما وغير كافية إلى حد كبير».[13] وكافكا على دراية تامة بقصور هذه الإستراتيجية، لأن القانون يردّ عليها بأن يجعل الاتهام نفسه هو الجرم ويتخذ من الافتراء على النفس أساسًا له. فبمجرد ما يتبين للقانون بطلان التهمة يصدر حكمًا بالإدانة، والأنكى، أنه يتخذ من حيلة الافتراء على النفس مبررًا أبديًا لوجوده. فبما أن الناس لا يتوقفون عن قذف أنفسهم وقذف غيرهم، يغدو القانون –أي المحاكمة– ضروريًّا للبت في صحة هذه الاتهامات. وهكذا يمكن للقانون أن يبرر نفسه، بتقديم نفسه كواقٍ من حمى اتهام البشر لأنفسهم (ولقد عمل كذلك بالفعل إلى حد ما، فيما يخص الدِين على سبيل المثال). وحتى لو كان البشر أبرياء على الدوام، حتى لو كان من غير الممكن لأي إنسان في العموم أن يكون مذنبًا (كما يرى يوزيف ك)، سيظل الافتراء على النفس موجودًا تماما كالخطيئة الأصلية، أو التهمة الباطلة بامتياز (par excellence) التي وجهها البشر إلى أنفسهم.[14]
8.
من المهم أن نميز بين الافتراء على النفس والاعتراف. عندما حضّت لِني (الممرضة) يوزيف ك على الاعتراف بقولها إن سبيل النجاة الوحيد المتاح أمامه هو أن يعترف بذنبه،[15] رفض ك. دعوتها على الفور. ومع ذلك، ترمي كل محاكمة إلى انتزاع الاعتراف. وفي القانون الروماني، يُعدّ الاعتراف ضربًا من إدانة النفس. فوفقًا لأحد الأمثال القضائية، من اعترف تنقضي محاكمته سلفًا. وشدد أحد أكثر الفقهاء الرومان تضلعًا، وبلا تحفظ، على التطابق بين الاعتراف وإدانة النفس بقوله: من يعترف يدين نفسه. لكن يستحيل على من افترى على نفسه أن يعترف لأنه هو المجني عليه أيضًا؛ ويستحيل على المحكمة أن تدينه كمتهِم إلا إذا تبين لها براءته كمتهَم.
وعلى ذلك يمكن تعريف إستراتيجية ك. (الافتراء على النفس) على نحو أكثر دقة بأنها المحاولة الفاشلة، لا لجعل المحاكمة مستحيلة، وإنما لجعل الاعتراف مستحيلًا. علاوة على ذلك، يقول كافكا في شذرة ترجع إلى سنة 1920: «أن يعترف المرء بذنبه يعني أن يكذب. لكي يعترف المرء لابد له من أن يكذب».[16] وبذلك، يبدو أن كافكا ينتسب إلى تقليد ينبذ الاعتراف بكل حزم (في مقابل التقليد اليهودي-المسيحي الذي يتمتع فيه الاعتراف بمقام عال)، انطلاقا من شيشرون الذي يرى أن الاعتراف شيء «بغيض وخطير»، وصولا إلى بروست الذي ينصحنا بلا مواربة قائلًا: «لا تعترف أبدًا».
9.
أهم ما في تاريخ الاعتراف، هو صِلته بالتعذيب، وهي الصلة التي كان كافكا ولا بد حساسًا حيالها. فبينما كان الاعتراف يُقبل بشيء من التحفظ، في روما الجمهورية، وكان يُستعمل أكثر للدفاع عن المتهَم، تضمنت الإجراءات الجنائية، في روما الإمبراطورية، تعذيب المتهَم –بجرائم مضادة للسلطة في المقام الأول كالتآمر على الحاكم وخيانته والكيد له وعصيانه، لكن أيضًا بجرائم من قبيل الزنا والسحر والكهانة المحرمة– وتعذيب عبيده بغرض انتزاع اعتراف منهم. «لانتزاع الحقيقة»، هذا هو شعار المنطق القضائي الجديد، الذي يربط بين الاعتراف والحقيقة على نحو وثيق، وبذلك يجعل التعذيب –الذي يمتد إلى الشهود أنفسهم في حالة التهمة بالخيانة العظمى– أداة الإثبات والتحقق التي لا تضاهى. ومن هنا اسمه في كتب القانون الروماني، «quaestio»، أي تحقيق أو بحث: التعذيب باعتباره بحث عن الحقيقة (quaestio veritatis). وباعتباره كذلك تحديدًا، سترثه محاكم التفتيش في العصور الوسطى.
بإدخاله إلى قاعة المحكمة، كان المتهَم يخضع لاستجواب أولي. وبمجرد ما يتردد أو يتناقض في كلامه أو حتى بمجرد ما يصرّح ببراءته، يأمر القاضي بتعذيبه. فيمدد المتهَم على ظهره فوق المخلَعة (باللاتينية «eculeus»، أي مُهر أو حصان صغير، ولهذا المرادف الألماني لكلمة تعذيب هو «folter»، وهي مشتقة من «fohlen»، أي مُهر)، ذراعاه مشدودان بقوة إلى الخلف، ويداه مربوطتان بحبل يمر من فوق بكرة، وبشده لهذا الحبل، يتمكن الجلاد من أن يخلع عظمة الترقوة. هذه هي المرحلة الأولى من مراحل التعذيب ومنها اشتق اسمه («torture» من «torqueo» اللاتينية والتي تعني اللوي حتى التكسير)، وعادة ما كانت تُتبع بالجَلد والتقطيع بواسطة الكلاليب والأمشاط الحديدية. ولقد كان هذا «البحث عن الحقيقة» عنيدًا وقاسيًا لدرجة أنه كان من الممكن له أن يمتد لأيام عديدة إلى أن يُنتزع الاعتراف في نهاية المطاف.
ومع انتشار ممارسة التعذيب، تُشرَّب الاعتراف وأضحى جزءًا من دخيلة النفس. وبالتالي عوضًا عن أن ينتزع الجلاد الحقيقة بالإكراه، أصبح المرء يدلي بها طوعًا بوازع من ضميره. وتورد لنا المصادر القانونية، وبشيء من الدهشة، قضايا يعترف فيها الأشخاص من دون أن يُتهَموا قط، أو بعد ما أن تبرئهم المحكمة بالفعل. لكن حتى في هذه القضايا، كان للاعتراف، بصفته «صوت الضمير»، قيمة إثباتية، ومن ثمّ كان يقتضي إدانة المعترف.
10.
ويبدو أن هذه الصلة الوثقى بين التعذيب والحقيقة هي تحديدًا ما أسر لُبّ كافكا على نحو يكاد يكون مَرَضيّا. فقد كتب إلى ميلينا في شهر نوفمبر من سنة 1920 قائلا: «أجل، التعذيب هو شغلي الشاغل. لماذا؟.. لكي أتعلم كيف أخرِج الكلمة اللعينة من الفم اللعين».[17] وقبل ذلك بشهرين، أرفق بإحدى رسائله إليها ورقة مخطوط عليها تصميم لآلة تعذيب من ابتكاره، آلية عملها موضحة بالكلمات التالية: «بعدما يُشد وثاق الشخص على هذا النحو، يُدفع القائمين ببطء إلى الخارج إلى أن ينشطر جسده، من المنتصف، إلى شطرين».[18] وقبل ذلك ببضعة أيام، شدد كافكا على أن التعذيب كان يستعمل بغرض انتزاع الاعتراف، مقارنًا حاله بحال رجل رأسه بين فكي مِلزمة وصدغيه بين مسماري التثبيت، لكن: «الفرق الوحيد بيننا هو.. أنني لا أؤجل صراخي إلى اللحظة التي يضيقون فيها المسمارين على رأسي حتى ينتزعوا مني الاعتراف؛ وإنما أشرع أنا في الصراخ بمجرد أن أراهم قادمين نحوي من بعيد».[19]
وما يبرهن على أن انشغال كافكا بالتعذيب لم يكن انشغالًا عابرًا، هو قصة «في مستعمرة العقاب» التي كتبها في بضعة أيام من شهر أكتوبر في سنة 1914، قاطعًا تأليفه لرواية المحاكمة. وفيها نجد أن «الآلة» التي ابتكرها «الحكمدار العجوز» هي آلة تعذيب وتنفيذ لحكم الإعدام في الوقت عينه (والضابط نفسه هو من أشار إلى ذلك، عندما تدارك أي اعتراض محتمل عليها قائلا: «لقد توقفنا عن استعمال التعذيب منذ العصور الوسطى»).[20] وبجمعها بين هاتين الوظيفتين، يغدو العقاب المنزَل بواسطتها على المتهَم متطابقًا مع ضرب بعينه من البحث عن الحقيقة، إذ من يكشف فيه عن الحقيقة، ومن ينطق بالحكم، ليس القاضي، وإنما المتهم نفسه، وذلك بقراءته للكلمات التي ينقشها مشط الآلة الحديدي في لحمه: «حتى إذا كان المتهَم من أغبى الأغبياء، فإن بصيرته تتنور حينها. يبدأ السطوع من حول العينين، ومن هناك ينتشر. في مشهد فاتن لدرجة أن المرء قد يُغرى في التمدد بجوار الرجل تحت المشط. ولا يحدث أي شيء آخر، سوى أنه يشرع ببساطة في فك شفرة ما كُتب في لحمه، فيزم شفتيه كما لو كان ينصت مصغيًا. وأنت ترى أنه من العسير أن تقرأ المكتوب بعينيك؛ لكن رجلنا يقرأه بجروحه. وهذا عمل مضنٍ بلا شك؛ إذ يحتاج إلى ست ساعات كاملة لكي ينجزه. لكن عندها يمزقه المشط كل ممزق، ثم يطوح به في الحفرة المليئة بالدماء وضمادات القطن».[21]
11.
كتب كافكا قصة «في مستعمرة العقاب» في أثناء تأليفه لرواية المحاكمة. والتشابهات عديدة بين حال الرجل المدان في القصة وحال يوزيف ك في الرواية. فكما أن ك. لا يعرف تهمته، لا يعرف الرجل المدان أنه قد أدين. وكلاهما لا يعرف الحكم الصادر في حقه (فسر الظابط علة عدم تبليغه بالحكم قائلًا: «وما المغزى من تبليغه به؟! فكما ترى، على الرجل أن يعرف الحكم بلحمه»).[22] وتُختتم كل من القصة والرواية، في الظاهر، بتنفيذ حكم الإعدام (وإن كان في القصة، الضابط هو من يعدم نفسه، على ما يبدو، عوضًا عن الرجل المدان). لكن هذه الخاتمة الظاهرة هي تحديدًا ما يتعين علينا التشكيك فيه. ففي القصة، لم يكن الأمر متعلقًا بتنفيذ حكم الإعدام وإنما بالتعذيب، والتعذيب وحده. وهذا ما نصت عليه القصة صراحة عند اللحظة التي تعطلت فيها الآلة: «ليس هذا هو التعذيب الذي أراد الضابط أن ينزله بالرجل، هذا ليس سوى قتل محض».[23] الغرض الحقيقي من الآلة، إذن، هو التعذيب باعتباره بحثًا عن الحقيقة؛ أما الموت، الذي يحدث عادة من جراء التعذيب، فهو مجرد أثر جانبي لاكتشاف الحقيقة، وليس مقصودًا بحد ذاته. وعليه، عندما تتعطل الآلة فلا تعد قادرة على جعل المدان يقرأ الحقيقة في لحمه، يتحول التعذيب إلى مجرد قتل.
ومن وجهة النظر هذه، ينبغي علينا أن نعيد قراءة الفصل الأخير من المحاكمة. فهنا أيضًا لا يتعلق الأمر بتنفيذ حكم وإنما بمشهد تعذيب. فالرجلين ذوي القبعتين اللذين يظهران ليوزيف ك كما لو كانا ممثلين ثانويين أو مغنيين حتى، ليسا منفذي أحكام، أو جلادين، بالمعنى القانوني للكلمة، وإنما «باحثان» عن الحقيقة، يسعيان إلى أن ينتزعا منه اعترافًا، لم يطلبه منه أحد حتى تلك اللحظة (ولو صح أن ك. هو من افترى على نفسه، فلعل ذلك تحديدًا هو ما أرادا منه أن يعترف به). ويدعم ذلك التوصيف الغريب الذي قدمه كافكا للقائهما الأول مع ك.: «لكن قبل المدخل مباشرة، شبكا ذراعيهما بذراعه على نحو لم يجربه ك. قط في مشية مع أي أحد. لقد ألصقا كتفيهما خلف كتفيه، ولم يلويا ذراعيهما وإنما طوقا بهما ذراعي ك. بطولهما، وأمسكا يديه بقبضة مدربة لا فكاك منها. وسار ك. محشورًا بين الرجلين بعسر شديد. وهكذا أصبح ثلاثتهم يشكلون وحدة واحدة بحيث لو سقط أحدهم أرضًا سقطوا جميعًا».[24]
حتى المشهد الأخير، حيث ك. ممدد فوق حجر في «وضعية متكلفة على نحو غير معقول»، أشبه بمشهد تعذيب فاشل أكثر منه مشهد تنفيذ حكم إعدام. وكما فشل ضابط «مستعمرة العقاب» في أن يجد في التعذيب الحقيقة التي كان يبحث عنها فيه، فإن موت ك. أيضًا أشبه بقتل محض أكثر منه بخاتمة بحث عن الحقيقة. ففي النهاية وجد ك. نفسه مفتقرًا إلى العزم اللازم للقيام بما عرف أن عليه القيام به: «أن يمسك بالسكين التي تتناقل هائمة من يد إلى أخرى من فوقه وأن يطعن بها نفسه».[25] فمن افترى على نفسه لا يمكنه أن يعترف بحقيقته إلا بتعذيب نفسه (فكما افترى على نفسه ينبغي أن يكون هو من يعذب نفسه). لكن ما جرى هنا أن التعذيب، وتمامًا كبحث عن الحقيقة، قد أخطأ مرماه.
12.
يفتري ك. (كل إنسان) على نفسه لكي يبعد نفسه عن القانون، أي عن الاتهام، الذي يبدو أنه موجه إليه لا محاله، وأنه لا فكاك له منه (فتصريحه بالبراءة من التهمة بلا قيمة، بما أن هذا ما يفعله المذنبون في الغالب، كما قال له قس السجن). لكن بافترائه على نفسه، ينتهي به الحال كالسجين، الذي تحدث عنه كافكا في إحدى الشذرات، الذي «يرى مشنقة منصوبة في فناء السجن، فيظن خطأ أنها معدة له دون غيره، فيهرب من زنزانته ليلًا، ويشنق نفسه عليها».[26] وهنا يكمن التباس القانون، فهو متجذر في افتراء الأفراد على أنفسهم لكنه يقدم نفسه باعتباره قوة خارجة عنهم ومتعالية عليهم.
ومن هذا المنظور تحديدًا، يتعين علينا أن نقرأ أمثولة أمام باب القانون التي قصها القس على ك. في مشهد الكاتدرائية.[27] فباب القانون هو الاتهام، الذي يدخل من خلاله الفرد إلى نطاق القانون. لكن من ينطق بأول وأهم اتهام هنا هو المتهَم (وإن كان في شكل افتراء على النفس). ولهذا السبب تتألف إستراتيجية القانون من دفع المتهَم إلى الاعتقاد في أن الاتهام (الباب) مخصص (ربما) له دون غيره؛ وفي أن المحكمة (ربما) تطلب منه شيئًا؛ وفي أنه (ربما) توجد محاكمة جارية متعلقة به. لكن في واقع الأمر لا يوجد اتهام ولا توجد محاكمة، على الأقل ما دام ذلك الذي يعتقد أنه متهَم لم يتهم نفسه بعدُ.
وهذا هو معنى «الخداع» (Täuschung) الذي يرى القس أنه لبّ الأمثولة («في كتب القانون التمهيدية، يقال التالي عن هذا الخداع: أمام باب القانون يقف حارس..»).[28] ولا تكمن المشكلة هنا، وكما يرى ك.، في تعيين من هو الخادع (حارس الباب) ومن هو المخدوع (الرجل الريفي). ولا هي تكمن أيضًا في تحديد ما إذا كانت عبارتا الحارس («لا يمكنني أن أسمح لك بالدخول الآن» و«هذا الباب مخصص لك وحدك»)[29] متناقضتين أم لا. فهما يعنيان التالي على أية حال: «أنت لست متهَمًا» و«الاتهام شأنك وحدك، فأنت وحدك يمكنك أن تتهم نفسك، وحينها، وفقط حينها، ستغدو متهَمًا». أي أنهما دعوة إلى اتهام النفس، إلى تسليم المرء نفسه إلى المحاكمة. ولهذا السبب أمل ك. في أن القس قد يعطيه «نصيحة حاسمة» من شأنها أن تساعده لا في التأثير على مسار المحاكمة وإنما في تجنبها بالكلية، في أن يعيش إلى الأبد خارجها، هو أمل خائب لا محالة. ففي واقع الأمر القس نفسه حارس أمام باب القانون، بل «ينتمي إلى المحكمة» حتى. ويكمن الخداع الحقيقي تحديدًا في وجود حراس الأبواب البشريين (أو الملائكيين: في التراث اليهودي، حراسة الأبواب إحدى وظائف الملائكة)، بداية من الموظفين البيروقراطيين البسطاء وصولًا إلى المحامين وكبار القضاة، الذين يرمون إلى حض بقية البشر على اتهام أنفسهم، أي دفعهم إلى المرور من الباب الذي لا يؤدي إلا إلى المحاكمة. ومع ذلك، لعل الأمثولة تتضمن «نصيحة» على أية حال: ليست المسألة هي دراسة القانون، وهي بحد ذاتها أمر لا ذنب فيه،[30] وإنما دراسة حرّاس بابه، التي كرّس الرجل الريفي لها نفسه سنين طويلة أثناء مكثه أمام القانون. فبفضل هذه الدراسة، هذا التلمود (المدراش) الجديد، نجح الرجل، وعلى العكس من يوزيف ك، في أن يعيش إلى آخر عمره خارج المحاكمة.[31]
[1] Franz Kafka, The Trial, trans. Breon Mitchell (New York: Schocken Books, 1998), p. 3.
[2] صديق كافكا الحميم، وكاتب سيرته، وزعيم التأويل الديني لمُبدَعِه. يرجع إليه الفضل في نشر الكثير من أعمال كافكا بعد وفاته، بامتناعه عن حرقها مخالفًا بذلك وصية كافكا.
[3] Davide Stimilli, “Kafka’s Shorthand,” paper delivered at the Warburg institute in London, May 20, 2006.
[4] The Trial, p. 14.
[5] بينما هو في غرفة جارته الآنسة بورستنر في وقت متأخر من الليل يحكي لها تفاصيل ما جرى في الصباح، طرق طارق بعنف على الباب ، مما يعني أن أحدا قد علم بوجود ك عندها في تلك الساعة المتأخرة. ولكي لا يظن أحد بالآنسة بورستنر السوء، خاصة صاحبة النزل السيدة جروباخ (التي تشك في سمعة الآنسة بالفعل)، عرض ك عليها أن تشيع عنه في اليوم التالي أنه اعتدى عليها بالأمس، وسيؤكد هو صحة زعمها.
[6] The Trial, p. 224.
[7] Franz Kafka, ‘He: Aphorisms from the 1920 Diary’, in The Great Wall of China and Other Short Works, ed. and trans. Malcolm Pasley (London: Penguin Books, 1991), p. 110.
[8] طرح أجامبين تحليلا مفصلا للفظ «causa» في كتابه:
Karman: A Brief Treatise on Action, Guilt, and Gesture, trans. Adam Kotsko (California: Stanford University Press, 2018), p. 1-23.
[9]* يعتبر أجامبين هنا الاتهام صلب المحاكمة (القانون)، لكن قارن مع تحليله لـ"محاكمة" المسيح، حيث اعتبر أن إصدار الحكم هو صُلب المحاكمها وجوهرها، وحاجج عن أن "محاكمة" المسيح قد زعزعت مبدأ إصدار الحكم (تمامًا كما أن الافتراء على النفس يزعزع مبدأ الاتهام)، لأنها كانت محاكمة من دون حكم، فبيلاطس لم يصدر فيها حكما على المسيح وإنما "سلّمه"، وبالتالي لم تكن محاكمة المسيح محاكمة حقًا، ومن ثمّ لم يكن صلبه "عقوبة" بالمعنى القانوني للكلمة. بصلبه دونما حكم، قوض المسيح القانون، عن طريق زعزعته لمبدأ إصدار الحكم الذي لا يمكن الخروج من المحاكمة إلا به، وبافتراءه على نفسه، قوض يوزيف ك. القانون، عن طريق زعزعته لمبدأ الاتهام الذي لا يمكن الدخول في المحاكمة إلا به، انظر:
Giorgio Agamben, Pilate and Jesus, trans. Adam Kotsko (California: Stanford University Press, 2015).
[10] The Trial, p. 213.
[11]* الفقيه المقصود هو القاضي الإيطالي سالفاتوري ساتا، وللمزيد عن تحليل أجامبين لفكرته هذه انظر:
Pilate and Jesus, p. 52-54; Karman, p. 6-7.
[12] The Trial, p. 94.
[13] Franz Kafka, The Castle, trans. Mark Harman (New York: Schocken Books, 1998), p. 252.
[14] للمزيد عن تحليل أجامبين لفكرة الخطيئة الأصلية انظر دراسته التالية:
The Kingdom and the Garden, trans. Adam Kotsko (London New York Calcutta: Seagull Books, 2020), p. 16-50.
[15] The Trial, p. 105.
[16] Franz Kafka, Dearest Father: Stories and Other Writings, trans. Ernst Kaiser and Eithne Wilkins (New York: Schocken Books, 1954), p. 308
[17] Franz Kafka, Letters to Milena, trans. Philip Boehm (New York: Schocken Books, 1990), pp. 214–15.
[18] Letters to Milena, p. 201.
[19] Letters to Milena, p. 198.
[20] Franz Kafka, ‘In the Penal Colony’, in The Transformation and Other Stories, ed. and trans. Malcolm Pasley (London: Penguin Books, 1992), p. 142.
[21] ‘In the Penal Colony’, p. 137.
[22] ‘In the Penal Colony’, p. 132.
[23] ‘In the Penal Colony’, p. 151.
[24] The Trial, p. 226
[25] The Trial, p. 230.
[26] Dearest Father, p. 87.
[27] «أمام باب القانون يقف حارس. وإلى هذا الحارس، يأتى رجل من الريف ويطلب منه أن يدخل إلى القانون. فيرد عليه الحارس بأنه لا يمكنه أن يسمح له بالدخول الآن. فيفكر الرجل لبرهة ثم يسأله عما إذا كان سيسمح له بالدخول فيما بعد. فيرد عليه الحارس قائلًا: ‹من الممكن، أما الآن فلا›. ولأن باب القانون مفتوح، كما هو حاله دائمًا، ولأن الحارس تنحى عنه جانبًا، ينحني الرجل لكي ينظر من خلال الباب إلى الداخل. وعندما يراه الحارس يفعل ذلك، يضحك ويقول له: ‹لو كان الدخول يغريك إلى هذا الحد فلتدخل على الرغم من حظري لذلك. لكن لتحذر، فأنا قوي، ومع ذلك فأنا أقل الحراس شأنًا. فمن حجرة إلى أخرى يقف حارس، الواحد منهم أشد بأسًا من الذي يسبقه. أما ثالثهم، فحتى أنا لا أطيق مجرد النظر إليه›. ولم يكن الرجل القادم من الريف يتوقع أن يجد كل هذه العقبات أمام القانون. إذ كان يظن أن الدخول إلى القانون ينبغي أن يكون متاحًا أمام الجميع على الدوام. لكنه عندما ينظر الآن بتمعن إلى الحارس بمعطفه الفرو وأنفه الضخم المدبب ولحيته التترية الطويلة الخفيفة السوداء، يخلص إلى أنه من الأفضل له أن ينتظر حتى يؤذن له في الدخول. يقدم له الحارس كرسيًّا ويدعوه إلى الجلوس في ناحية أمام الباب. وعليه يجلس الرجل أيامًا وأعوامًا. وفي الأثناء يقوم بمحاولات كثيرة للدخول طالبًا الإذن من الحارس الذي ضاق ذرعا بطلباته. وعادة ما كان الحارس يستجوبه بإيجاز، طارحًا عليه بعض الأسئلة عن بلده وعن أشياء أخرى، لكنها أسئلة لا مبالية، كتلك التي يسألها الرجال ذوي الشأن بدافع من اللطف. وفي كل مرة يختم استجوابه مشددًا مرة أخرى على أنه لا يسعه أن يأذن له بالدخول بعدُ. ولأن الرجل قد تزود لرحلته بالكثير من المتاع، فقد راح يرشو الحارس بكل ما بحوزته مهما عظمت قيمته. وأخذ الحارس كل ما أعطاه له الرجل، وفي كل مرة كان يشفع ذلك بقوله: ‹أنا آخذ ذلك منك لا لشيء إلا لكي لا ترى أنك قد فشلت في فعل أي شيء›. وطوال كل هذه السنين، كان الرجل يراقب الحارس بلا انقطاع تقريبًا. إذ نسي الحراس الآخرين، وبدا له أن هذا الحارس الأول هو العقبة الوحيدة التي تحول بينه وبين الدخول إلى القانون. في السنوات الأولى، كان، وبشيء من الطيش، يلعن حظه التعيس جهارًا، لكن بعدما شاخ راح يغمغم باللعنات بينه وبين نفسه. وأصابه الخرف، فبعد السنين الطويلة التي قضاها في دراسة الحارس، أصبح على معرفة حتى بالبراغيث التي تكمن في ياقة معطفه الفرو، وراح يطلب من هذه البراغيث أن تساعده في إقناع الحارس بالسماح له بالدخول. وأخيرًا، أخذ بصره يضعف، ولم يعد يعلم ما إذا كانت العتمة تلف الأشياء من حوله حقًا أم أن عينيه هما اللتان تخدعانه. لكن في قلب هذه العتمة ظل يرى نورًا، لا ينطفئ، يبرق من خلال باب القانون. ولم يعد متبقيًا من عمره إلا القليل. وقبل موته، تكثف في رأسه كل ما مر به أمام القانون في سؤال واحد لم يطرحه على الحارس بعد. فيلوّح إلى الحارس، بما أنه لم يعد قادرًا على رفع جسده المتصلب. وتعين على الحارس أن ينحني إليه بشده، بسبب الفرق الهائل بين حجم جسده وحجم جسد الرجل. ثم سأله قائلا: ‹ما الذي لا تزال تريد أن تعرفه الآن؟ يا من لا يروى له غليل!› فرد الرجل بقوله: ‹الجميع يصبو إلى القانون، ومع ذلك، لم يطلب أي أحد غيري الدخول إليه طوال كل هذه السنين، فكيف لذلك أن يكون؟› ورأى الحارس أن الرجل يحتضر بالفعل، ولكي يصل صوته إلى سمعه الآخذ في الزوال، صاح فيه قائلًا: ‹لم يكن لأي أحد غيرك أن يدخل من هنا، لأن هذا الباب مخصص لك وحدك. والآن سأمضي إلى إغلاقه›».
[28] The Trial, p. 215.
[29] The Trial, p. 217.
[30] في تأويله لأمثولة كافكا «المحامي الجديد»، رأي أجامبين، مقتفيًا في ذلك أثر فالتر بنيامين، أن فحوى الأمثولة هو التالي: دراسة القانون المحضة، أي دراسته لأجل دراسته لا لممارسته، ومن ثمّ «تعطيل» القانون، هو باب العدالة. وإليكم نص الأمثولة: «التحق بنا محام جديد إسمه بيوسيفالَس [اسم فرس الإسكندر الأكبر]، لا يختلف شكله عما كان عليه، حين اختاره الإسكندر المقدوني فرسًا يمتطيه أثناء القتال. لو تفرست فيه لوجدت لديه الكثير مما يثير الانتباه. قبل زمن رأيت أثناء هبوط السلالم حاجب محكمة يتفحص المحامي الجديد بعيني مدمن على سباقات الخيل، مندهشًا، وذلك أثناء ما كان هذا يقفز بخفة فوق درجات السلالم، واحدة بعد الأخرى رافعًا عجزه، ولوقع أقدامه على المرمر ضجيج كبير. جاءت موافقة المكتب على التحاق بيوسيفالَس به، انطلاقًا من إجماع مدهش بأنه سيعاني في ظل النظام الاجتماعي الراهن صعوبات كثيرة، لهذا وبسبب أهميته التاريخية وجدناه يستحق الانضمام إلى فريقنا. اليوم، وهذا أمر لا ينكره أحد، لم يعد الإسكندر المقدوني حاضرًا، غير أن هناك بيننا من يجيد القتل ويمتلك مهارة كبيرة في طعن الصديق بالرمح عبر مائدة الطعام. ربما ضاق أحدنا ذرعا بمقدونيا فيلعن فيليب، والد الإسكندر، متناسيا أنه ما كان لنا أن نصل الهند بدونه. حتى في ذلك الوقت كانت بوابات الهند بعيدة عن المنال، إلا أن الطريق إليها كان مخطوطًا على سيف الملك. الآن تغير موقع هذه البوابات وازداد ارتفاعها، ولم يعد هناك من يدلنا على الطريق، رغم كثرة رافعي السيوف، ومنهم من يلوح بها، تلاحقه نظراتنا الزائغة. ربما، ولهذا السبب بالذات، فإن أفضل ما يمكن القيام به هو السير على خطى بيوسيفالَس الذي انصرف لدراسة كتب القانون، تحت ضوء المصباح الهاديء، حُرًا، لا يشعر بضغط سيقان الفارس على جانبيه، بعيدا عن ضجيج معارك الإسكندر، يقرأ ويقلب صفحات كتبنا القديمة» (ترجمة صالح كاظم عن الألمانية). وفقًا لتأويل أجامبين، وبنيامين من قبله، ليس السبيل إلى الهند (العدالة)، إذن، هو أن نخوض المعارك، شاهري السيوف (ممارسة القانون)، وإنما أن ننصرف إلى دراسة القانون فحسب (تعطيله) تمامًا كما فعل المحامي الجديد. أو بعبارة أجامبينية أخرى: السبيل إلى العدالة هو «اللعب» بالقانون، أي استخدامه استخدامًا مغايرًا (دراسته) للاستخدام المكرس له (ممارسته). انظر:
Giorgio Agamben, State of Exception, trans. Kevin Attell (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), p. 63-64.
[31] طرح أجامبين فيما مضى تأويلًا مختلفًا لأمثولة «أمام القانون» في سياق تحليله لمسألة المسيحانية والقانون عند فالتر بنيامين. وفقًا له، ترمز الأمثولة إلى وضعية القانون (الشريعة) في الزمن المسيحاني: الباب المفتوح يرمز إلى قانون ساري المفعول لكنه معطل، أي قانون مطبق تحديدًا عن طريق عدم تطبيقه، قانون قائم لكنه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء. وأن الرجل من الريف يرمز إلى شخص المسيح في آخر الزمان، الذي يتمكن بواسطة صبره الذي لا ينفد من غلق الباب، وبالتالي إيقاف سريان القانون. انظر:
Giorgio Agamben, “The Messiah and the Sovereign: The Problem of Law in Walter Benjamin”, in Idem, Potentialities, trans. Daniel Heller-Roazen (California: Stanford University Press, 1999), p. 172-174.
الترجمة خاصة بـBoring Books.
يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.
