لماذا نحن عدميون على الفيسبوك؟
مقال لمينا ناجي
خاص بـ Boring Books
يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بمقاله دون إذن منه
***
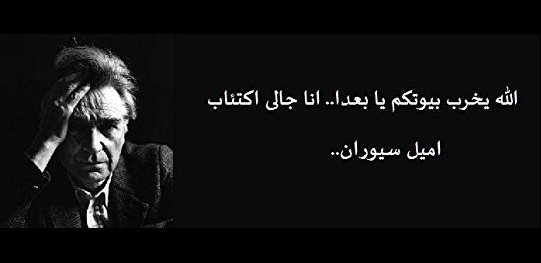
منذ بضع سنوات كنت في جلسة خاصة، وكان يسخر الحاضرون فيها مما يسمى «التنمية البشرية»، ويرددون ما كانوا يكتبونه على حساباتهم من التنكيل بأشكال التعامل الإيجابي مع الحياة مثل تقدير الأشياء الجيدة في حياة الواحد، الاهتمام بالعلاقات والصداقات، عدم الاستسلام للأفكار السوداء والمؤذية، السعي للتحقق في الحياة العملية، الالتزام بأهداف عامة وخاصة واضحة، إلخ. فتدخلت واحدة من الجالسين وقالت بخجل إنها حين تسقط في الاكتئاب تفعل هذه الأشياء رغم تكرارها الدائم لما يقولون. وبشكل دفاعي برَّرت بأنها لو لم تفعل ذلك لانتحرت منذ زمن طويل، ثم صمتت، وبعد تفكير قالت بما يشبه الاعتراف: «بل أنا أؤمن بهذه الأشياء».
على عكس توقعها، لم يُبدِ أحد اعتراضًا على ما قالته، بل انتقلت دفة الحديث إلى أهمية أن يتعامل الواحد مع الحياة بإيجابية وتقدير وحب، مع التأكيد بين الحين والآخر على استغلالية من يدعون قدرتهم على تحويل حياة البشر من دجالي التنمية البشرية.
الازدواج الغريب
يمكن رؤية السيل الجارف من النكات ومقاطع الفيديو المركبة والمنشورات والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي كشكل من البوح بالآلام الخاصة، مُغلَّفًا بالسخرية المتذاكية والمرحة: أشكو لك أنني أعاني بلا حول لكن في نفس الوقت أضحك كأنني متجاوز هذا الوضع، أشارك بحماس رأيًا يائسًا ومريرًا في شكل مفارقة أؤكد دقتها وحذاقتها، دون إشارة صريحة أن هذا الأمر يخصني، مما يرفع التحرُّج أو الفضح بشكل مباشر.
بذلك تُكثِّف مواقع التواصل الاجتماعي حضور خطاب التشكي الذي سرعان ما يُظهِر، بشكل جمعي، تبنِّي موقف نفي مطلق ومتشكك ساخر للقيم والمعاني: الحبُ خدعة وهرمونات تافهة (مع الهمس المتذاكي أن لا أحد يؤمن بالحب سواك)، الزواجُ بوابة ملكية للبؤس والغش والخيانة، الصداقةُ رابط شكلي بلا قوام تحدِّده الصدفة، الإنجاب تدمير للحرية الشخصية وراحة البال، التعليم بلاء لا مفر منه، العملُ خطة جهنمية للتعذيب اليومي، السياسةُ مسرحية أليمة لممثلين فشلة، إلخ. وكلما نجح أحدهم في تجسيد رسالة أن ظواهر الحياة الاجتماعية المشتركة بلا معنى، وأن المعاني كلها سراب، كان أشد ذكاءً وفطنة وجديرًا أكثر بالـ«لايك» والـ«شير»، مما يجعل لمواقع التواصل تأثيرًا على انتظام خطابي واسع، يضرب حدوده حول منطق يائس وعدمي.
هذه العدمية و«السينيكيَّة» التي يُعبَّر عنها من قطاع كبير من المجتمع على حساباتهم، وتنعكس بشكل متخف في قلب كثير من الممارسات اليومية والأيديولوجية، تكون في مجتمع أغلبيته لا تزال تحب وتتزوج وتنجب وتتعلم وتعمل، بل تصارع وتكافح في تلك المجالات، وفي أحيان أخرى ومتزامنة، يشاركون الإعجاب الرومانسي بصورة طفل يضحك ببراءة أو صورة زوجين متحابين وسعداء، والتهنئة بالنجاح والحصول على شهادات، والتقدير لمدة طويلة من الصداقة العميقة بين شخصين، إلخ.
وحتى في مجالات أكثر وعيًا بذاتها مثل الفكر والأدب، يمكن رؤية هذا الازدواج الغريب في الظواهر المنتشرة منه. فبالنظر مثلًا إلى شعبية الكاتب أحمد خالد توفيق الراجعة أساسًا إلى سينيكيته وكشفه للـ«واقع»، في مقابل الملحميَّة والتماهي الأيديولوجي عند زميله نبيل فاروق مثلًا، تجد توفيق متدينًا محافظًا في طرحه الفكري مثل زميله، وكل سينيكيته الطفولية منصبة على سطح الظواهر، التي حين يتعمق فيها يتماهى تمامًا مع الأيديولوجيا الدينيَّة في محاولة لإعطائها منطقًا عقلانيًا. وكذلك برصد التيار الطويل من الكُتَّاب والمثقفين الذي يتعاملون مع القضايا الحياتيّة من منطلق ليبرالي تقدُمي في كتاباتهم النظرية، نجدهم برؤى محافظة رجعية في قناعاتهم الفعلية، وبانتهازية ودناءة في ممارساتهم العملية. هذه المستويات الثلاثة المتضاربة قادمة أساسًا من التعامل مع الثقافة بوصفها رصيدًا اجتماعيًا وليس نشاطًا عضويًّا حياتيًّا، المصحوب بـ -أو بسبب- عدمية أخلاقية عميقة تتغلَّف بقناعاتٍ دينيَّة في موقع صنمي «فيتشي» من وعيهم.
الأيديولوجيا الدينيّة أو احتقار الحياة
كيف لم يحافظ الغطاء الديني على المجتمع من الوقوع في فخ العدمية؟ يأتي هذا من فشل المنظومة الدينيَّة الوظيفي في المجتمع. فاليقين الديني تحول إلى نوع من العدمية المخادعة، بإزاحة مضامين الحياة الحيوية والمتغيِّرة بتثبيتات ميتة لا يمكن تطبيقها في الحياة بشكلها المتحجر. وتتجلى هذه العدمية في احتقار «الفلسفة» و«الثقافة» بمعنيهما الخاص بالتفكير في كيفية العيش: لا تسأل كيف نعيش أو لماذا، فالإجابة موجودة ومعروفة ومقدسة، لكنها لا تعنينا في شيء، لأنها أيضاً غير حقيقية ولا تسد شيئًا.
يتكامل مع هذا الفصل بتغلغل مبدأ «الذنب» في بنية الشعور الديني؛ اليقين الديني في أمان من كل نقد، نحن من أسقطنا أنفسنا، وسقوطنا يأتي من عدم اتباعه، لكنه بعيد كل البعد عنا. لتكتمل بذلك دائرة مفرغة، فالشعور بالذنب غير موضوعي، ويتذيَّل بتبريراتٍ وتفسيراتٍ تهرب من مجابهة المسؤولية عن الخطأ، فكل أيديولوجيا لا يمكن التعامل من خلالها بواقعية ما في الحياة، تستتبع إدماجها للذنب في قلب منظومتها: أنا مذنب وأنتظر أن يُعفى عني، لأستكمل طريقي في كوني مذنبًا مجددًا. في حين أن «الخطأ» موضوعي وتاريخي ويمكن تحديده ومواجهته والتعامل معه. الذنب ينفي المسؤولية بشكلٍ خبيث، في حين أن الاعتراف بالخطأ يأتي من قلبها. فكلما جابهت أحدهم بتناقضه في أفعاله أو سلوكه، فاجأك بقوله «كلنا مذنبون»، وبينما يبدو من هذا الرد التواضع والوعي بالتناقضات، إلا أنه يعمل في الحقيقة كتبرير للاستمرار دون العمل على حل هذه التناقضات المؤذية والمنحطة والتعايش غير المسؤول معها.
الفشل في التوليف بين الأخلاق العملية والمثاليَّة الروحيَّة، يعني بمعنى أوسع فشل الثقافة. ومن هنا جاء الازدواج العملي الآخر في رفض تغيير الفكر مقابل تغيير السلوك أو عدم ربطه بالسلوك، من التجاوزات والجرائم الأخلاقية إلى الأنشطة الحياتية مثل الاختلاط والحب والجنس وسماع الأغاني، إلخ. لأن ذلك سيعتبر عبثًا بالخريطة المعرفيَّة والأساس الأيديولوجي لذوات ليس لديها ما تواجه به الدنيا سوى هذه الأيديولوجيا، ولذا يتم انتهاك الدين عمليًّا، مع الحرص على عدم المساس بموضعه وشكله، فتسمع مثلاً عن مؤمن يسكر ويستأجر بائعة هوى مع صديقه غير المؤمن، الذي حين يبدي سخريته من فكرة صيامها يكون ذلك سببًا للعراك بينهما.
لماذا نحن عدميون؟
التفلسف الضمني بقول إن كل شيء سواد وبؤس وشر، هو هروب من سؤال الشر والعنف والمهمة الفكرية، برسم حدوده وطرح احتمالات معناه. ولذا يساعد هذا النفي العدمي للقيم والمعاني المشتركة والمؤسسات الحاملة لها (مثل الأسرة، التعليم، الزواج، العمل، إلخ..)، في إعطاء القدرة على نقدها ومهاجمتها دون بذل عناء فهم أسباب تعطلها وفشلها في إشباع الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع منها، وفسادها التاريخي من حداثة ملتبسة في وضع ما بعد كولونيالي حافظت على نمط تفكير ديني ما قبل حداثي، وضعف قدرات الدولة الراعية لمواطنيها التي أنشأتها دولة ما بعد الاستقلال القومية، والفساد السياسي البنيوي الذي هتك المجال العام بصفته مجال المصالح الخاصة في تفاعلها الاجتماعي إلخ. دون فتح مساحات حقيقية لتعديل أو استبدال هذه المؤسسات أو الخروج عنها أو مناقشة مدى وحدود المسؤولية الذاتية عنها.
بانتفاء مساءلة حدود الشر والعنف، ورفع المسؤولية عنهما، يرجع، مثلما في المجال الديني، ليتمركز مفهوم الذنب مرَّة أخرى بشكل علماني؛ فلأول مرَّة ترى انتشار إدانة الجنس البشري بأكمله بصفته مذنبًا في تخريبه الكوكب والطبيعة وبقية الكائنات الحية من حيوانات وأشجار، أو أفعال قسوة وعنف مسجلة بالكاميرات التي تتواجد في كل مكان، إدانة شاملة تنهمر في منشورات وتعليقات مثل: الجنس البشري خراء، الإنسان لعنة الكوكب، يا رب نيزك يقضي على البشر. ما هو مهم في هذه الإدانة وشموليتها، هو موقعها الذي تنطلق منه. فهذه الإدانة لا يمكن إطلاقها إلا من قبل إله ما، أو كيان خارج الجنس البشري، يراه ويحاكمه من الخارج. ولذا فما يظهر في نهاية المطاف، هو أن هذا الخطاب الميسنثروبي (كراهية الإنسان) المنتشر ليس إلا شعورًا ذاتيًّا متضخمًا بالذنب، معمَّمًا ومبهمًا ولا يمكن التعامل معه.
ما يسيِّد هذا التفلسف الضمني العدمي هو الركون إلى يأس ساكن يتم التدرب عليه لأنه أكثر راحة من ألم خيبات أمل مستمرة. كما أنه يتيح، في نفس الوقت، الظهور بمظهر الفطنة والذكاء في الوصول إلى ما وراء الظواهر الخادعة وفضح فراغ كل شيء وبؤسه. كما أنه يعتبر أيضًا البوابة الضرورية للتمتع المازوخي بالتأسي البطولي وترفُّع الضحية، مع الإرجاء الممنهج للحياة. يمكن رؤية هذا التمتع الليبيدي في إدمان المعاناة في الكثير من التجليات الفنية المختلفة من مسلسلات وأفلام وأغانٍ بما فيها من مبالغات ميلودرامية في ردود الأفعال والمواقف. وبذلك يمكننا تعريف هذا المجتمع بالمجتمع العُصابي، الذي يخادع الموت بالتظاهر بالموت عبر التأجيل الدائم للحياة، والذي يأتي من الخوف من الحياة الحقيقيَّة بكل وطأتها ومسؤوليتها، مع الاشتياق الدائم لها، وهو عنوان التشكي والتظلم العدمي المستمر.
اقرأ المزيد: كراهية البشر ليست حلًا مع الأسف

8 ردود على “لماذا نحن عدميون على الفيسبوك؟”
تحليل منطقي، لكن بالمقابل هناك اتهام ضمني للأشخاص الأقرب بإحساس للاجدوى، من أنهم يرغبون بالظهور في هذه الصورة العدمية، وهذا بتصوري يحمل جزءً لا بأس به من التجني على الحقيقة الواضحة بأن عالم اليوم بكل مقوماته الفكرية والاجتماعية والاقتصادية تدفع الإنسان بشكل كلي للوصول إلى إحساسه العدمي رغماً عنه، وما يبيح هذا الاندفاع بشكل جلي هو التناقض الذي كتبته مينا ناجي بأن إنسان اليوم الأكثر عدمية هو من يدافع في الحصول على ما يرفضه من حب وزواج وتهنئة.. الخ.
أعتقد أن المسألة ليست تمظهراً، فجزء كبير من عدميِّ الفيسبوك هم عدميون فعلياً على الأرض، وما محاولة البحث عن سبل للحياة إلا هي نزوع طبيعي لتناقضة فكرة وجودهم الأرضي، فمن الطبيعي أن يبحثوا عن حياة جيدة ويمارسونها مثلما هي من علاقات. الاجتماع البشري لا يعني أبداً اللاعدمية، والإحساس باليأس المطلق ولا جدواه لا يفترض أبداً الانعزال الأبدي.
وربما خير مثال يمكن تقديمه لنزعة العدم البشري وحفاظه على العلاقات الإنسانية هم أدباء أوروبا بعد الحرب العالمية. ما يجري من نزعة عدمية في وسائل التواصل اليوم لا تلغي أبداً الرغبة بالحياة وتكوينها لكن ضمن منطق مغاير عن السائد، لذا يمكن لنا مشاهدة النزوع الثوري الاجتماعي في الفيسبوك مثلاً ممتزجاً بعدمية الوجود.
عدمية السوشيال ميديا هي رفض النمط الذي كثيراً من الأفراد لا يستطيعون رفضه مجتمعياً.
شكراً علي على ردك المهم،
في الحقيقة الموقف العدمي كموقف وجودي من الحياة شيء له وجاهته ويحترم، اللي المقال بينتقده هو التضارب العجيب في القناعات (لأسباب كتير حاولت أظهرها في المقال) في مجتمعنا واللي هو يختلف في رأيي عن الموقف العدمي الفلسفي في السياق الغربي، السياق الغربي فيه ما يسمح بأخذ موقف عدمي من المعاني الاجتماعية والوجودية، لأنه فيه مؤسسات معاني بالأصل شايله المجتمع ككل وتسمح لأفراده بدا، إنما العدمية اللي في مجتمعاتنا هي عدمية جمعية من نوع آخر قايمة على الفشل في تمثل المعاني في مؤسسات وعلاقات مشتركة، ودي عدمية مش فلسفية ولا وجودية حتى لو تظاهرت بدا.. ودا اللي بيعمل التناقض بالشكل العجيب دا
شكراً لاهتمامك والرد مينا.
أنا لم أتوقف عما جاء في المقال من باب النقد بقدر ما هو محاولة فهم أعمق.
ما اعترضت عليه نسبياً (وما تم إثباته من خلال تعليقك) هو رفض هذه النظرة الجمعيّة. يمكن أن نقول أن مجتمعاتنا تعاني إحباط عام ناتج عن علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية متخلفة، لكن هذا الإحباط لا يمكن وصفه بالعدمي في مرحلة أولى، لكنه باب للولوج أكثر في هذه التجربة الذهنية والثقافية مستقبلاً.
أوروبا عندما اتخذت موقفاً عدمياً من الحياة والفكر، ليس لأنها تمتلك مؤسسات، بل على العكس، عمل منظومة المؤسسة هي التي طوّرت الفهم العدمي لديهم، لأن المؤسسة (كمفهوم شامل) هي من اخترعت الموت المؤدلج اتجاه قضايا كبيرة كالوطن والقومية وحتى الدين. في مجتمعاتنا آخر عشر سنوات، تمظهرت المؤسسات (التي لم يكن لها وجود سابقاً) بفعل حقيقي على الأرض كصورة تنازع الشعوب، لقد تحولت إلى مؤسسة حقيقة في صناعة الموت، وهذا أحد أهم أبواب الانطلاق لتجلي الإحساس العدمي والذي سيصبح فهماً فلسفياً مع التقادم الزمني في أي مجتمع، لذا لا أعتقد أن نقد هذه العدمية والتناقضية في التعبير على وسائل التواصل لأنها تقوم على فشل جمعي. صورة الزمن تختلف لكن المعطيات واحدة .. فالاوتوقراط السياسي الألماني بعد الحرب الأولى كمثال هو نتاج عديمة الهزيمة بالنسبة للشعب الألماني، تماماً مثلما العلمانية القومية التركية وانهياراتها الاجتماعية.
المقال وملاحظاتك رائعة لكن (وعذراً على هذا التعبير) هناك نفس استعلائي على هذه التجربة التي تتمخض حديثاً بعدة أشكال.
مجتمعاتنا تعاني انهيار بنيوي، معرفي، وأخلاقي قاسي جداً.
أظن يا علي أن جملتك الأخيرة بتلخص الدافع وراء كتابة هذا المقال، وقرايتي لأسباب الانهيار القاسي معرفياً وأخلاقياً هو وجود عدمية عميقة في قلب المجتمعات بتاعتنا، ومشكلتها أنها مختفية ومتوارية ولا يمكن تأسيس شيء عليها، ودا اللي بيخلي الانهيار بهذه القسوة، فراغ مرعب بيبلع كل شيء في وضع شديد القساوة حتى بمقارنة مع تجارب دول أخرى في وضعنا وأسوأ بتحاول تخرج من أزماتها.
أنا لازلت بشوف أن السياق الغربي وتأزمات وتناقضات حداثته (ومن ضمنها ما بعد الحداثة كأحدى هذه التجليات) مختلفة كلية عن عدميتنا اللي بتعبر عن انحطاط وإفلاس إنساني حتى لو حاولت تتلبس مسوح تجاوز الحداثة والتنوير، والمؤسسات اللي أنت بتتكلم عنها في صراعات السنوات الأخيرة أخدت شكل جماعاتي في الدفاع عن وجودها الهش والمختل أساساً لأسباب تاريخية يطول سردها، وأنا بالفعل بنهي المقال بإشارة أن ثقافة الموت هي ثقافة الشعوب قبل ما تكون ثقافة المؤسسات السياسية دي.
أما الموقف العدمي اللي بياخد موقف شجاع وواعي من الوجود فمعنديش مشكلة معاه ولا أتعالى عليه، بالعكس، بشوف فيه زي ما قلتلك وجاهة وحجة، لكن على الواقع قليل من صادفتهم عندهم هذا النوع من العدمية.
الموضوع فعلاً شائك ولا يمكن الإحاطة به ضمن تعليقات.
بكل الأحوال، شكراً على الحوار وعلى وقتك.
وشكراً ليك علي للمناقشة المهمة اللي أضافت للمقال
تحليل رائع ويتضمن كل ما نراه يومياً
شكراً لك على هذا المقال
أنا لسه شايف الكومنت يا أمينة والله 😀 .. العفو، وشكرًا على تعليقك