اللهو بأنفسنا: تربية جمالية للقرن الحادي والعشرين
مقال لسورتي سينغ*
ضمن سلسلة «حول نشوء أبراج الحمام»**
ترجمة: حسين الحاج
*سورتي سينغ أستاذة مساعدة في الفلسفة في الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة. تخصصت في فلسفة القرن العشرين القارية اﻷوروبية والنظرية النقدية وفلسفة الجمال والنسوية. تستكشف أعمالها الحديثة موضوعات في فلسفة الجمال من وجهة نظر النظرية النقدية المبكرة، ونظريات الصورة والخيال في إطار التحليل النفسي والفينومينولوجيا والنظرية الاجتماعية، والمقاربات النسوية للذاتية.
** ترجم هذا البحث ضمن مشروع لتأليف أربعة بحوث فلسفية حول المبادئ اﻷساسية لما أسماه مؤسس معهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة (سيلاس)، كريم ياسين جوسنجر، ببرج الحمام. أطلق كريم على هذا المشروع «حول نشوء أبراج الحمام»، راميًا إلى تشبيه سيلاس ببرج الحمام، بعكس ما يعرف عن الجامعات الحديثة بأنها «أبراج عاجية». المؤلفون المساهمون في هذا المشروع فلاسفة أكاديميون. تخصص اثنان منهما في الفلسفة القديمة والاثنان اﻵخران في الفلسفة المعاصرة. وقد قدموا بحوثًا حول المبادئ اﻷساسية اﻷربعة التي تنبثق من تجربة سيلاس وتستلهمها، وهم التنوع واللهو والحميمية والجهل.
الترجمة خاصة بـ Boring Books ومعهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة (سيلاس)
يحتفظ المترجم بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بترجمته دون إذن منه.
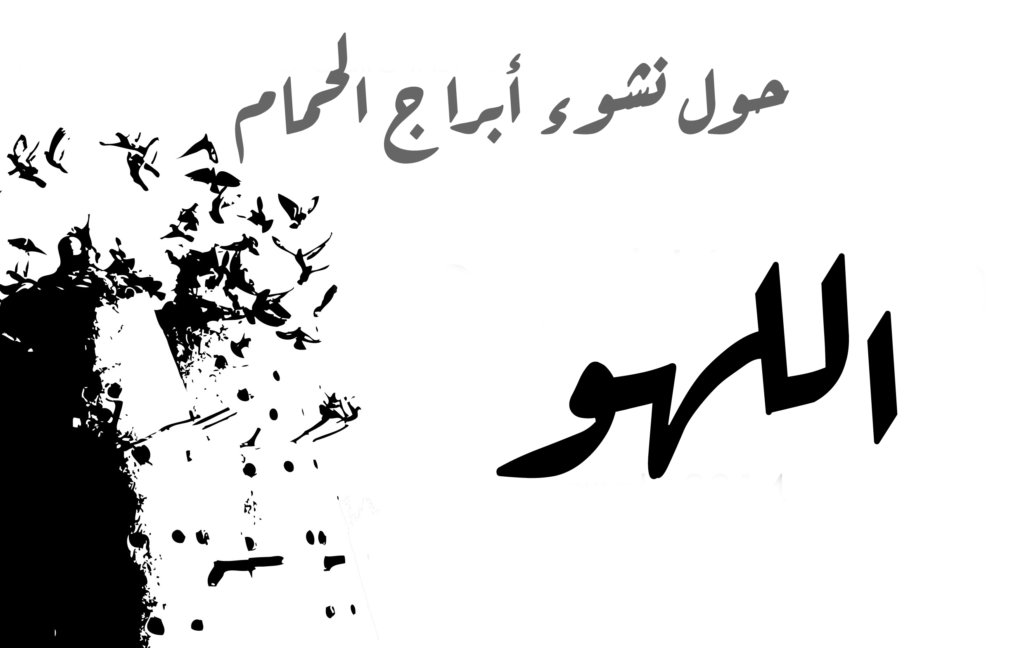
ما دور التعليم في زمن الثورة المضادة؟ أشار اقتراح فريدريك شيلر في كتابه «رسائل حول التربية الجمالية للإنسان» إلى الحاجة إلى تعليم ينمي الحس اﻷخلاقي للإنسان، وقد قدم ذلك الاقتراح بعد تحطم آمال الثورة الفرنسية على يد اﻹرهاب الوحشي الذي لحقها. إن اختزال الفرد إلى مجرد ترس في الماكينة، مجردًا من قدراته الفكرية ومقيدًا بنظام بيروقراطي مختل، ترك اﻹنسانية مقيدة في انتقالها من الطبيعة إلى الثقافة، فلا تستطيع أن تدعي أنها بلغت الحضارة ما دامت المنافسة العدائية بين سماتها الرئيسية، الحس والعقل. وﻻ يمكن رأب ذلك الصدع حتى يصبح الفرد منفتحًا على إمكانية هذا التحول. لذلك شجع شيلر التربية التي توقظ الفرد وتحييه وتعيد وصله حتى يصبح قادرًا على الدخول في حالة أخلاقية ملائمة.
التفت شيلر في رسائله إلى السؤال حول ما إذا كان العلم أو الفن يمكنهما أن ييسرا هذه التربية. إذا تم النظر إلى الفن تاريخيًا باعتباره قوة مفسدة مقارنةَ باﻹنجازات النبيلة للعلم، فقد قدم شيلر لفتة جريئة. لقد نزع كلًا من الفن والعلم من المجال الاجتماعي لكي يصبح محتملًا لهما أن يؤديا تلك الوظيفة، لكن شيلر لاحظ أن رغم تأكيد العلم على العقل، إلا أنه ينمي الجانب المتجرد من اﻹنسان بينما ما نحتاج إليه هو شيء تقبله الحواس، أو الجانب اﻹنساني الذي أصبح مستنزفًا بصورة متزايدة بسبب عقلانية التنوير الصارمة والمسيطرة بشكل مبالغ فيه. وقد وضع شيلر في اعتباره أن ذلك الشيء هو علم الجمال، وفي الحقيقة، ﻻ يمكن أن يتحقق نوع التربية الذي يتخيله شيلر إﻻ في بعده الجمالي، وهي مرحلة ضرورية يجب على الفرد أن يمر عبرها: «يعاني اﻹنسان في حالته البدنية من هيمنة الطبيعة، لكنه يحرر نفسه من تلك الهيمنة في الحالة الجمالية، ويتقنها في الحالة اﻷخلاقية».
ألهمت إمكانيات البعد الجمالي عددًا من المفكرين في القرن العشرين، الذين اعتبروا في أعمالهم أن قوته قادرة على تحدي المجتمع الميكانيكي الصارم، خصوصًا أولئك الذين ارتبطوا بنظرية مدرسة فرانكفورت النقدية في أوائل القرن العشرين. فكر جورج لوكاش، وفالتر بنيامين، وثيودور أدورنو، وهيربرت ماركوزه من بين آخرين بجدية في حالة الفن وعلم الجمال باعتبارها خبرة يمكن لها أن تخفف هيمنة ملكة العقلانية وعنفها. سيتأمل هذا المقال في معنى التربية الجمالية اليوم من خلال الاستدلال بتلك المصادر، حيث أنه يعتبر سؤالًا متعلقًا بالمجتمع المصري المعاصر الذي على الرغم من اختلافه عن ذلك المجتمع الذي شخصه شيلر إﻻ أنه يعاني من الثورة المضادة. في هذا السياق، تأسس معهد القاهرة للعلوم واﻵداب الحرة (سيلاس) في 2013، بعد انتفاضات ثورية هزت المنطقة وفتحت إمكانية لوجود مستقبل مختلف لبرهة من الوقت. تتبنى سيلاس مفهوم اللهو بصفته واحدًا من مبادئها الراسخة، وهو مفهوم مركزي في طريقة تخيل شيلر إمكانية وجود التربية الجمالية، وتميز نفسها باعتبارها «برج حمام»، أي مساحة للتأمل بين ضغوط الواقع والانفصال الفكري للأبراج العاجية. وإنني أقدم الرؤى التالية واضعة في الاعتبار ذلك النموذج.
***
في منتصف الخمسينيات، نشر هربرت ماركوزه كتاب «اﻹيروس والحضارة»، وهو اجتهاد ماركسي فرويدي في التفكير في إمكانية التحرر من النزعات القامعة لرأسمالية القرن العشرين. يراجع ماركوزه في هذا الكتاب «رسائل حول التربية الجمالية للإنسان» لشيلر، ويرى أن هدفه أن «يتجه إلى إعادة إنشاء الحضارة، بالاستناد إلى القوة التحريرية للوظيفة الجمالية، وبذلك فقد نظر إلى هذه الوظيفة باعتبارها تحتوي على إمكانية إيجاد مبدأ جديد للواقع».تعمل هذه القوة التحريرية للوظيفة الجمالية من خلال فكرة شيلر حول دافع اللهو. ففي رأي شيلر، يوفق هذا الدافع بين الجانبين المتعارضين للإنسان، اللذين يتصور أنهما دافعا الحس والشكل. وتنبع العدائية المتبادلة بين كلا الدافعين من اختلاف أهدافهما، فاﻷول يؤكد على الجانب المادي من اﻹنسان، بينما يؤكد الثاني على استقلال اﻹنسان عن الطبيعة. يصالح دافع اللهو بين الحس والعقل من خلال مناغمة وظائفهما المتعارضة معًا وإنتاج هدف ثالث، ألا وهو الجمال. فتجربة الجمال ليست عائدة إلى حاجتنا اﻷساسية للبقاء وﻻ إلى نشاطنا الذهني من أجل بلوغ الحقيقة أو المعرفة. بل تصبح تجربة الجمال وحدة بين الشكل والحس هادفة إلى استبصار هذا الانسجام. ورغم أن شيلر تصور أن البعد الجمالي ليس إلا مرحلة انتقال بين الطبيعة والثقافة، إﻻ إنه، كما لاحظ بعض المعلقين عليه، يصبح في بعض اﻷحيان غاية في حد ذاته، وانسحابًا من العالم إلى براح الطبيعة الجمالية، وجمالًا ينبعث باعتباره مثالًا لا يمكن تجسيده في الواقع مطلقًا. وﻻ تقترح رسائل شيلر بالنسبة إلى ماركوزه انسحابًا هادئًا داخل عالم الجمال غير متأثرة بتقلبات الحياة اليومية، بل باﻷحرى، تحتوي بذور تحرر البعد اﻹيروسي، أو مملكة الحرية من خلال قراءة ماركوزه الفرويدية.
إذن تعيد قراءة ماركوزه لشيلر طرح سؤال اﻹيروس في سياق التربية، والذي هو موضوع قديم في تاريخ الفلسفة. فإذا كان أفلاطون حقق نموذجًا للتربية حيث يسخر اﻹيروس للسعي الفكري السامي نحو المعرفة، يرى ماركوزه اﻹيروس بصفته طارحًا إمكانية وجود إنساني غير مستلب أو مقموع. وإذا كان العقل أو النطاق المميز للوجوس بالنسبة لأفلاطون يقمع اﻹيروس في النهاية، فإن ماركوزه يسعى إلى تحريره، ويحاول أن يفي بوعد دافع اللهو عن طريق تجذيره في الغرائز الفرويدية، وعدم تقييدها بعالم العمل، وتحريرنا المحتمل من متطلباته. ويقتبس ماركوزه ثلاثة عناصر جوهرية من رسائل شيلر التي يؤمن أنها ستؤدي إلى تكوين مجتمع غير قمعي:
- تحول الكدح (العمل) إلى لهو، واﻹنتاجية القمعية إلى «إنتاجية حرة»، وهو التحول الذي ينبغي أن يسبقه الانتصار على الحاجة (الندرة)، هذا الانتصار هو العامل المحدد للحضارة الجديدة.
- التصعيد الذاتي للحساسية (أي الغريزة الجنسية) وتذليل العقل (أي الغريزة الشكلية) بهدف إعادة التوافق بين الطرفين المتناقضين.
- الانتصار على الزمن من حيث أن الزمن يدمر اﻹشباع الدائم.
تتماثل غاية السمات الثلاث بالنسبة لماركوزه في التصالح بين مبدأ الواقع ومبدأ اللذة، حيث يرى البعد الجمالي من خلال التخيل بصفته ملجأً للعمليات العقلية ومحررًا من مبدأ الواقع القمعي.
يدعو ماركوزه إلى تحويل العمل أو الكدح إلى لهو، وتحويل النزعة اﻹنتاجية القمعية إلى إنتاجية حرة. وما يتطلبه هذا التحول مسبقًا هو القضاء على الندرة أو تحقيق ما يمكن تسميته بمجتمع الوفرة. فعندما تشبع الحاجة إلى البقاء، يتحرر الفرد من العمل بصفته كدحًا ويستطيع اختبار العمل بصفته لهوًا. تتم صيغة هذا التحول باعتباره تحولًا من النزعة اﻹنتاجية القمعية إلى إنتاجية حرة، أو تحول في علاقة الفرد بعملية اﻹنتاج في العموم من عمل مستلب مقيد إلى مبدأ المردود إلى عملية ترضي رغبات الفرد. يمكن للعمل بالنسبة إلى ماركوزه أن يصبح شكلًا من النشاط الممتلئ باﻹيروسية، حيث يخضع إلى الحاجات التي تسمح للإنسانية بالازدهار.
ﻻ يتضمن اللهو وطمأنينة الحاجات باعتبارهما مبدأي الحضارة مجرد تحويل العمل فحسب، ولكن ربطه التام بممكنات اﻹنسان والطبيعة، المتطورة بحرية. وبذلك تكشف فكرتا اللهو وطمأنينة الحاجات اﻵن عن كل المسافة التي تفصلهما عن قيم اﻹنتاجية والمردود. فاللهو هو بالتحديد غير منتج وغير نافع، ﻷنه يرفض الملامح القمعية والاستغلالية للعمل وأوقات الفراغ، فهو «لا يفعل شيء سوى أن يلهو».
عندما يصبح العمل لهوًا، فإنه يتخذ سمات مناقضة لشروط شكله المستلب، فالعمل اللاهي، الذي لن يعد مدفوعًا بقوة النزعة اﻹنتاجية والحاجة إلى الكفاءة فحسب، يصبح أيضًا بلا غاية أو هدف من وجهة نظر العمل التقليدي. ويلاحظ ماركوزه من حيث ذلك أن غاية النشاط وليس محتواه هو الذي يميز العمل عن اللهو. ﻷنه إذا أرضى النشاط حاجاتنا الغرائزية، فهو إذن يعتبر لهوًا، وهو ما يتصوره ماركوزه تحولًا من العمل إلى اللهو، وتحولًا من نشاط مقيد بحب البقاء إلى نشاط يفضي إلى تحقق الذات، وذلك تحول ستتم مناقشته لاحقًا.
ثانيًا، يدعو ماركوزه إلى إعادة التوازن بين العقل والحس، أي تصعيد ذاتي من شأن الحس وتذليل العقل. فإذا كانت غرائزنا اﻷساسية بالنسبة إلى فرويد أنتجت رغبات واهية وجب عليها التسامي أو أن تتحول إلى أهداف مناسبة أكثر، فإن القمع الغريزي الفرويدي يتخذ في إطار رأسمالية القرن العشرين شكلًا إضافيًا من «القمع الفائض»، الذي من خلال مبدأ المردود يولد استبداد العقل على الشعور في القهر على العمل. تصبح وحدة العقل والشعور قاعدة الثقافة التي من خلالها ﻻ تصبح اﻹنسانية مقيدة بالكدح، بل باﻷحرى، متطورة من خلال اللهو. هذه رؤية مختلفة بشكل جوهري عن الشكل الموجود من الجنسانية، التي اصطلح عليها ماركوزه باسم التذليل القمعي.
في كتاب اﻹنسان «ذو البعد الواحد»، ناقش ماركوزه مجتمع اﻹشباع الفوري، حيث تصبح الجنسانية مسلعة ومتحكمًا فيها اجتماعيًا. ويمكننا القول بطريقة فوكوية إنه كلما تم التعبير عن الرغبة أكثر من خلال وسائل الخطاب الخاضعة للنظام الحالي، فإنها تصبح منظمة أكثر. سيعكس تذليل العقل والتصعيد الذاتي للشعور أو الجنسانية بالنسبة إلى ماركوزه حاجاتنا الحقيقية بدلًا من المصطنعة. ومن خلال التصعيد الذاتي للجنسانية، يشير ماركوزه إلى احتمالية وجود جنسانية تخلق «علاقات إنسانية متحضرة بدرجة عالية دون أن تخضع إلى التنظيم القمعي الذي فرضته الحضارة الراهنة على الغريزة» تحت ظروف معينة. وعلى الخصوص، فإن الظروف الضرورية لمثل هذه الاحتمالية ستكون تطور مؤسسات ليست محكومة بمبدأ المردود. سيسمح هذا بتحول الجنسانية من شكلها المنحط في مجتمع اﻹشباع الفوري إلى أن تصبح إيروسية. ويقدم ماركوزه رؤية لهذا المجتمع الذي يحكمه اﻹيروس:
إلغاء العمل، وتحسين البيئة، والانتصار على المرض والهرم، وتحقيق الرفاه. وإن جميع هذه الأنشطة إنما تصدر مباشرة عن مبدأ اللذة، وهي في الوقت ذاته، تنشئ العمل الذي يجمع اﻷفراد في «وحدات متزايدة من الشمول»، وبذلك لا تبقى محصورة ضمن المجال المشوَّه التابع لمبدأ المردود، فتقوم بتحويل الغريزة دون أن تحرفها عن هدفها. فحيثما يوجد التصعيد توجد الحضارة، غير أن هذا التصعيد يعمل ضمن نظام من العلاقات اللييبدية المتنامية والدائمة والتي ما هي إلا علاقات عمل في حد ذاتها.
إذن، يخلق التسامي الذاتي للجنسانية نحو اﻹيروسية علاقات عمل غير مستلبة، مثلما يعتمد عليها أيضًا. تعمل ضرورة الصراع من أجل الوجود بصفتها سندًا للإيروس بدلًا من أن تكون قمعًا للحرية الغرائزية. يعود ماركوزه بنا إلى النقطة اﻷولى التي ناقشناها مسبقًا، وهي تحول العمل إلى لهو، متسائلًا عن الشروط الغريزية لدمجهما معًا. فكما رأينا مسبقًا أن العمل واللهو يبدوان في البداية متعارضين تمامًا، حيث ﻻ يحفز اللهو أي هدف عدا إشباع الرغبات الغريزية، بينما يحفز هدف البقاء الخارجي العمل. يمكننا أن نرى اﻵن أن هناك فكرة أوضح حول كيفية تحول العمل للهو، فبينما سيحافظ النشاط على الغاية نفسها، وهي غاية البقاء، لكن من خلال القضاء على الندرة والاستلاب، يمكن للعمل في الوقت ذاته أن ينشط اﻹشباع الغرائزي. إذن، يجادل ماركوزه أن التغير اﻻجتماعي سيكون ضروريًا من أجل تنمية الشروط الغريزية التي يمكن أن تحول العمل إلى لهو.
ثالثًا، يجب تفكيك آلية الوقت الانضباطية، فبالنسبة إلى ماركوزه، ينقسم يومنا إلى وقتين: وقت للعمل ووقت فراغ، حيث يصبح اﻷخير محددًا بجرعات محددة في عالم يحكمه مبدأ المردود، ويقمع هذا التقسيم أبدية مبدأ اللذة ورغباتها، حيث يصبح وقت الفراغ بلا غاية، وليس راحةً من العمل أو وقتًا كي يستعيد المرء طاقته من أجل أن يصبح أكثر إنتاجية. سيفكك تحرر اﻹيروس، والذي هو مصدر السعادة الحقيقية بالنسبة إلى ماركوزه، النظام القمعي للوقت في المجتمعات الحديثة.
تطرح قراءة ماركوزه لشيلر عددًا من القضايا، وخصوصًا فيما يتعلق بملاءمتها لنموذج من التربية وإمكانية جعل اللهو ركيزة أساسية لها. أولًا، يتطلب تسخير اللهو في اﻹطار التربوي تأملًا حول كيفية ربط اللهو بالعمل، أو بصورة أدق، كيف يمكن لنوع العمل الذي نؤديه في الفصول الدراسية، بصفتنا طلابًا ومدرسين، أن يتخذ شكلاً لاهيًا. ما يتصل بذلك سيكون فكرة عن نموذج تربوي محفزًا ﻹشباع رغبات الفرد الغرائزية بدلًا من أن يكون محفزًا بغاية دمج مشاركيها في عالم العمل المستلب في النهاية. ويطرح هذا سؤالًا حول كيفية استمرار العمل الذهني غير المسخر من أجل إنتاج المعرفة العلمية وما الذي سينتجه؟ ثانيًا، سيتوافق مزج التربية باﻹيروس، من وجهة نظر ماركوزية، مع اﻷهداف الثورية، حيث يصبح الهدف ليس حيازة المعرفة والحقائق، بل تغيير كلٍ من الذات والمجتمع القمعي الذي يعيش فيه المرء. إذا كان اللهو بحسب ماركوزه يسهل تحقيق الرغبات والنزوع، فإن هذا سوف يعني في اﻹطار التربوي أن الفرد سيختبر نفي ذاته أو ذاتها الحالية. هل يمكن للتربية أن تفي بمثل تلك التجربة من النفي بدون غاية محددة في الذهن بوعد الحصول على مقام أفضل مما بدأ به المرء؟ وأخيرًا، سيفترض الركيزة اﻷساسية للهو أن التربية يمكن أن تستمر طبقًا لنموذج مغاير من الوقت، تحكمه إيقاعات اللاوعي بدلًا من الممارسات الواعية في القراءة والكتابة والتحدث. ربما يمكننا أن نستقي نموذجًا من جلسات جاك لاكان التحليلية ذات المدى الزمني المتغير، حيث لم يكن هناك حدود مقررة مسبقًا للوقت ويمكن أن تنتهي في دقائق معدودة أو تمتد إلى ساعات طويلة. وكذلك، ربما نفكر إذا رغبنا في جعل التربية نفسها نوعًا من المعالجة النفسية، كي تتوافق تحديدًا مع تلك الجوانب التي تربط وجودنا بالشعور، والجنسانية، والغرائز، والدوافع، واللاوعي.
ربما يمكننا أن نواجه بعض تلك اﻷسئلة من خلال ملاحظة أن الفن والبعد الجمالي هما ارتكاز فكرة ماركوزه عن التحرر، يحتملان تجربة النفي. ففي مملكة اللهو يقصي الفن نفسه عن عالم العمل الميكانيكي ويقدم مبدأ جديدًا للواقع. فعلى سبيل المثال، بحث فالتر بينامين، الذي كان متحمسًا للهو بنفس قدر حماس ماركوزه، عن تجربة واقع آخر في ظهور الميديا الجديدة والاحتمالات الثورية للأفلام، التي لم تعد خلق خبرة استلاب الجماهير وتشظيها فحسب من خلال خصائصها الشكلية، بل كشفت أيضًا عن أبعاد وعناصر غير متاحة لنا في حياتنا اليومية، ووفرت تجربة أسماها بنيامين اللاوعي البصري. كما أننا نستطيع أن نفكر في حركات القرن العشرين الفنية التي اعتنقت مبدأ اللهو، من الفن جاهز الصنع لدوشامب وأعمال الكولاج للحركة الدادائية إلى شعر السورياليين. ويمكننا أن نلتفت إلى اﻹنتاج الجمالي في مصر على وجه الخصوص، حيث «لعب» السورياليون المصريون ذات مرة في ذات البناية التي تضم معهد القاهرة للعلوم والآداب الحرة اليوم، منخرطين في ممارسات تأملية ومنتجين في الساعات المتأخرة من الليل أعمال فنية في حالات تقترب من النشوة، والتي كانوا يحرقونها فيما بعد. كما يمكننا أن نفكر في المواقفيين الذي أتوا في أعقاب السورياليين في باريس في الستينيات وأحدثوا تدخلات جمالية في الحياة اليومية، من خلال استخدام إستراتيجية الانجراف الثورية التي أصبحت المنهج اﻷساسي في اختبار الزمان والمكان بصورة مختلفة عن طريق التجول بلا هدف بدلًا من المشي بغاية محددة.
أصبح اللهو في الثقافة المعاصرة مكيفًا أكثر داخل عالم العمل والاستهلاك، ويعرب ظهور التكنولوجيات الحديثة بصورة متزايدة عن التفرقة بين اللهو ونفيه. فاللهو، الذي يخاطر بصورة مستمرة باندراجه تحت غرض التسلية ويصبح مجرد سلعة أو باندراجه تحت غرض العمل، يحتفظ في الوقت نفسه بقدرته على خلخلة المؤسسات واﻷنشطة التي يحكمها مبدأ المردود، ويظل مرتبطًا بوعد السعادة. يمكننا أن نفترض أن تضمين اللهو بصفته ركيزة أساسية في التفكير في تحول التعلم اﻷكاديمي التقليدي إلى شكل من أشكال اللهو يقدم وهم القدرة التخيلية على خلق عالم آخر غير حقيقي.
***
من خلال التفكير في الطرق التي يمكن أن يصبح اللعب بها جزءًا من العملية التربوية، يمكن لنا أن نطبق القضايا السالف ذكرها على مثال من الثقافة الجماهيرية يتخيل عالمًا يحكمه منطق اللعب. فقد تلقى مسلسل الخيال العلمي واﻹثارة الويسترن التلفزيوني «وست وورلد» Westworld الذي أنتجته شركة HBO إشادة مباشرة بعد عرضه في 2016. و«وست وورلد» متنزه خيالي مقام في الصحراء ومصمم طبقًا لنمط عيش الغرب اﻷمريكي، تسكنه روبوتات ذكية تبني منازلها في ذلك العالم، وتستضيف فيه زبائن من عالم البشر يطلقون عليهم «الضيوف». يتتبع المسلسل تجارب الضيوف فائقي الثراء الذين يمرون في ذلك العالم بتجارب هائلة كي يعيشوا نزواتهم، والتي تتلخص في غرائزهم الفرويدية المتمحورة حول الجنس والموت، كما يتتبع كذلك تجارب اﻷندرويدات التي تتفاعل مع أولئك الضيوف.
يثير السؤال الذي يعاود ظهوره كثيرًا أثناء المسلسل الحوارات التي تدور بين الضيوف والمضيفين: ما هي الغاية من «وست وورلد»؟ توجد إجابتان لذلك السؤال، اﻷولى وصفية والثانية معيارية: تدعي بعض شخصيات المسلسل أن الغاية من الدخول في ذلك العالم اللعبي هو أن نعلم من نحن حقًا. يخلق «وست وورلد» الظروف التي بموجبها تستطيع الشخصيات أن تتصرف طبقًا لرغباتها بدون حكم أو عقوبة، نازعين عن أنفسهم اﻷعراف والتقاليد التي تحكم حياتهم الحقيقية، وبالتالي، يبدو أن ما يختارونه في «وست وورلد» يظهر ذواتهم الحقيقية من خلال اتباع نزوات مبدأ اللذة ضد الذات التي يجب أن تكيف نفسها كي تلائم متطلبات مبدأ الواقع. بينما تؤمن شخصيات أخرى أن الدخول في «وست وورلد» يرينا ما الذي يمكن أن تكونه. يصبح اﻷفراد قادرين على تنمية نسخ جديدة من أنفسهم بعد انفتاح عالم الممكن، وسرعان ما يصبح جليًا أن المسلسل يركز على خبرات اﻷندرويدات التي تبدأ في التوق إلى ما يمكن أن تكونه. يحظى الذكاء الاصطناعي بإعجاب وخوف مثير في الكثير من المسلسلات التلفزيونية واﻷفلام والروايات التي عكست سيناريوهات حالمة وكابوسية، تظل المهمة واحدة في جميع النماذج المستهلكة بدءًا من فيلم ماتريكس Matrix وبليد رانر Bladerunner إلى التكرارات الحالية لذلك الموضوع في فيلم هي Her وإكس ماشينا Ex Machina. تقدم معرفة المرء لذاته، ليس بصفته فردًا فحسب بل باعتباره بشرًا، بصفتها مهمة استكشاف من خلال كائن القرن الحادي والعشرين اﻵخر، اﻷندرويد.
اﻹجابة قاتمة لمن يقتدون باﻷطروحة اﻷولى القائلة إن غاية «وست وورلد» أن يعرف المرء نفسه، فعندما يسقط البشر أولويات الحضارة الحديثة ويسمح لهم بالانغماس في حالة الطبيعة حيث يصيرون ملوكًا وملكات، تصبح الحياة بالنسبة إلى اﻷندرويدات كابوسًا هوبزيًا: موحشة وقاسية وقصيرة. كما تسود الفوضى بدون قيود الزواج والحرب التي تضعها الحضارة للجنس والموت. ليست هناك كراهية للنساء مقتصرة على الطرق التي تغتصب بها اﻷندرويدات اﻹناث وتهاجم وتقتل فحسب، كما أشار بعض المعلقين، بل يقترب المسلسل أيضًا من كراهية البشر، ففي أحد المشاهد يمضي اﻷبطال خارج الحدود، ويقدمون على الدخول في ديستوبيا روبوتية مليئة بالجنس والموت، حيث ينخرط كل ضيف في أفعال عنيفة وفاحشة، فبعدما دخلوا تلك المساحة، يعلق أحد الضيوف قائلًا إن الشخص الذي صنعها يجب أن يكون إنسانًا كارهًا للبشر.
هناك غاية للمعاناة في أكثر لحظات المسلسل ظلامية، فمؤسس «وست وورلد» الذي يشبه اﻵلهة، روبرت فورد، يستخف بشريكه القديم، آرنولد، لاعتقاده في أنه يمكن للروبوتات أن تحوز الوعي ببساطة من خلال وعيها بنفسها، لكن فورد نيتشوي واثق من نفسه، فعلى النقيض من رؤية آرنولد الديكارتية للوعي، لا يستمتع البشر بمعاناتهم فحسب، بل إن المعاناة هي أول من يحيي الذاكرة. ففي كتاب «أصل اﻷخلاق وفصلها»، وصف نيتشه كيف تمتع البشر بالنسيان الهانئ حتى تعلموا أن يتذكروا من خلال اﻷلم. يمكن للذاكرة فقط بالنسبة إلى فورد أن تبدأ في تجذير الوعي اﻹنساني في الروبوتات، فذاكرة المعاناة هي ما تنزل الروبوتات من عليائها كي تصبح قريبة من البشر. ورغم ذلك، ﻻ يبدو أن البشر قادرون مطلقًا على التعامل بشكل جيد مع المعاناة. فهناك رجل يدعى ويليام، وقد دفعه نسيبه وشريك أعماله قسرًا للمجيء إلى «وست وورلد»، يجد نفسه منجذبًا بصورة متزايدة نحو الواقع البديل الذي كان متشككًا فيه في البداية، ثم يقع في النهاية في حب أندرويد تدعى دولوريس. تلقى بالتأكيد هذه القصة العاطفية مصير الفشل، وعندما يشعر ويليام رفضًا من حبيبته، التي يتسبب فقدان ذاكرتها المعتاد في نسيانها لتجاربهما المشتركة، يمتلئ بكراهية وحقد ﻻ يمكن تصوره، والذي يتمثل في ظهوره مرة بعد مرة على مدى ثلاثين عامًا باعتباره معذب دولوريس. يبدو البشر اﻵخرون أيضًا محصنين من التعلم من المعاناة، لكن اﻷندرويدات هم من يمرون بهذا التغير في بدء تحولهم ﻷن يصبحون بشرًا. تغير المعاناة الطريقة التي يفهم بها اﻷندرويدات أنفسهم وتفتح احتمالية وجود مسار مغاير عما يلاقيه البشر.
يوازي عالم اللعبة الماكينة الرأسمالية، والتي تؤكد تكرار الخبرات نفسها بلا نهاية في المساحات التي من خلالها ينتمي اﻷفراد إلى طبقة محددة وخلفية مهنية معينة. مثلما تصدح اﻷغنية نفسها في الصالونات وتقع المحادثات نفسها بين المضيفين، يبدأ عالم اللعبة في التماثل مع الماكينة الرأسمالية بشكل مخيف، حيث تعاد تجاربنا بلا نهاية، فاﻷندرويدات مترجمة كي تؤدي دورها مرارًا وتكرارًا وتعيد قصص يشترك فيها الضيوف من البشر ويتفاعلون معها بلا نهاية مع اختلافات طفيفة. هذه الحلقة اﻷبدية تستند على محو الذاكرة والنسيان الذي يبقي اﻷندرويدات مقيدة بمصيرها. فليس هناك ما يحفزهم للخروج من حلقاتهم المفرغة والرغبة في الاستقلال والحرية من مصيرهم إﻻ الميلاد غير المتوقع للذاكرة، وتحديدًا ذاكرة المعاناة. تولد الفاعلية بوجود الذاكرة والرغبة، ويتحقق في اللهو الخطوة اﻷولى نحو التحرر.
يمزق الوعي المترقي للأندرويدات الفرق بين اللهو ونقيضه والذي هو شرط نجاح «وست وورلد». فبينما يدرك الزبائن الذي يدخلون «وست وورلد» جيدًا هذه التفرقة، ويدركون أنهم يمثلون ضامنين أنهم لا يمكنهم أن يجرحوا أو يقتلوا في هذا العالم اللعبي، يعتقد المضيفين من الروبوتات هذا العالم المتخيل أنه حقيقي. وعندما تبدأ الروبوتات في التساؤل حول واقعهم، يبدأ تشوش الفرق بين اللهو ونقيضه. في الموسم اﻷول من المسلسل، تبدأ الروبوتات في اختبار خلل فني يتشكل في صورة ذكريات وأحلام تبدأ في خلق سردية داخلية للصدمة، وهي صفة داخلية للبشر لم تملكها اﻷندرويدات بعد. في أساس القصة، ليس عالم اللهو إلا عالمًا خاليًا من اﻷلم لكل من الضيوف والمضيفين، فهو خالٍ من اﻷلم للضيوف ﻷنهم ﻻ يمكنهم أن يقتلوا في هذا العالم الوهمي، وهو خالٍ من اﻷلم للمضيفين ﻷنهم ﻻ يستعيدون أي معرفة من اﻷهوال التي يلاقونها على يد الضيوف. لكن عندما يبدأ بعض الضيوف في التذكر، يتصدع واقعهم الخالي من اﻷلم. وتبدأ اﻷندرويدات في التساؤل حول واقع تجربتهم من خلال استحداث ذاكرة لها. كما أنهم يشرعون في التكاثر ماديًا من خلال خلق عوالم داخلية سرية ومحاكاة شخصياتهم من أجل أن يحافظوا على مظهرهم، وسرعان ما يطورون رغبات ليست جزءًا من طبيعتهم المبرمجة. تدخل اﻷندرويدات مملكة اللهو بشكل فعال، منتزعين من آنية عالمهم الحسي اليومي ومكرهين على عالم من التأمل. ويختبرون للمرة اﻷولى وحدة بين عالم الشعور الذي ينخرطون فيه، وعالم الوعي، الذي حتى اﻵن ما زال مستعصيًا. والنتيجة هي خلق مثال غير معروف أو معرف، ألا وهو الحرية.
يجادل اﻷنثروبولوجيون أمثال روجيه كايوا ويوهان هويزنجا أن ليس الخداع والمحاكاة والسرية إلا بعض أشكال اللهو. ومن هذا المنطلق، يتطور الوعي من خلال اللهو. يعيش اﻷثرياء أحلامهم بالجنس والعنف من خلال اللهو المسلع والمختبر بصفته راحةً وتخففًا من ضرورات العمل، ومن ثم يتخذون صفات المتعة الحيوانية التي شخصها ماركس في تحليل للعمل المستلب. وعلى النقيض، تلهو اﻷندرويدات كي تصبح بشرًا وتؤكد إنسانيتها. فعندما يلهون، فإنهم يختبرون أنفسهم قياسًا إلى المثال، والذي هو الوجود الحر المستقل. لكن الروبوتات تلعب بدون أن تعرف ماهية الشيء الذي يحاكونه، فهم لديهم شعور أن هناك عالمًا آخر أكثر واقعية موجود، لكنهم لا يعرفون ما هو هذا العالم.
***
قصد الاستطراد حول «ويست وورلد» أن يبين أن اللهو هو ما يجعلنا بشرًا، فهو ما يخلق مسافة بيننا وبين استيعابنا الفوري للعالم من خلال المكر والاستعراض والمحاكاة وصولًا إلى إدراك الوعي في النهاية. إذن، فالطريق إلى الوعي بالذات يجب أن يمر من خلال الجمال أو باب المظاهر. إذا كان اللهو ركيزة للتعليم العالي، فربما علينا التخيل أن اللهو يخلص الذات من نفسها، وهو ما يتطلب القدرة على التظاهر، أن يصبح المرء شخصًا آخرًا بدون أن يفقد المرء نفسه. ويتطلب ذلك التصديق في الأوهام والقدرة على الاعتراف أن كلاهما زائف وحقيقي. ليست فكرة تعليم الآداب الحرة نفسها إلا جزءًا من وهم التنوير، والذي يجب أن يتم معاملتها بأقصى درجات الجدية، وفي الوقت ذاته يجب التلاعب بها، فالأشياء التي نشهدها يجب أن نعتبرها حقيقة كما علينا أن نفهمها باعتبارها زائفة. تلك القدرة على إيجاد المفارقة بين الحقيقة والزيف تكمن في قلب التعلم والمعرفة ويمكن أن تؤدي إلى قدرة أكبر على تفكيك الأوهام القامعة وخلق أوهام تؤمن الإشباع، وتعد بإصلاح ذواتنا المتشظية والمضطربة. إذن، يعتبر اللهو بصفته مبدأ محوريًا نوعًا من التأمل الذاتي وسعيًا نحو وعي المرء بنفسه، وتواصلاً ليس مقيدًا بقواعد المنطق كما قدر له أن تتم تأديته بل طبقًا للقدرة على تقويضها. ليس التعليم الذي يوفره اللهو إلا تعليم للذات، ولا يمكن لهذا أن يسقط عليه الضوء إلا في نقطة الالتقاء الغريبة بين ما يجعلنا بشرًا وما يمزق هذا الحاجز، وما يجعل الحضارة متماسكة وما يهددها بالانهيار. وبعبارة أخرى، فاللهو يرتبط باللذة كما يشدنا على طريق المعاناة. يتضمن اللهو الذهاب إلى أبعد مما يمكن أن يكونه الواقع، وربما حتى أبعد مما يجب أن يكونه. أن نتبنى التربية الجمالية يعني أن نختبر تحورًا في الذات، في النقطة التي يلتقي فيها الحس والعقل.

رد واحد على “حول نشوء أبراج الحمام | سورتي سينغ: اللهو بأنفسنا”
Where can I get the original English version pls ?