لن تتكلم لغة كيليطو
مقال: باسم عبد الحليم
يحتفظ الكاتب بحقه في المساءلة الأخلاقية والقانونية إذا تمت الاستعانة بمقاله دون إذن منه.
***

في الهوة التي تخلقها الترجمة بين لغة وأخرى يقع المعنى. المعنى ابن للّغة وليس للأفكار، والآخر لا يرانا كما نرى أنفسنا، بل كما ترانا لغته، وبكل ما تعنيه هذه الكلمة (اللغة) من سياقات ثقافية واجتماعية وطبوغرافية. حول هذا الطرح تحديدًا؛ كيف نرى أنفسنا وكيف يرانا الأخر؟ يدور كتاب عبد الفتاح كيليطو، الصادر عن دار الطليعة ببيروت، «لن تتكلم لغتي». محاولًا نقل النقاش إلى مستوى أبعد، وهو كيف نرى أنفسنا عبر رؤيتنا للأخر؟
الترجمة اللغوية ممكنة؛ نقل اللفظ من وعاءٍ إلى آخر. ولكن تكمن الصعوبة في الترجمة الثقافية؛ أي نقل المعنى من سياق إلى آخر. يصف كيليطو في الفصل الأول من كتابه حالة مشابهة، حين طُلِب منه أن يُحاضِر عن «مقامات الهمذاني» إلى جمهور أوروبي. شعر كيليطو أن عليه إثبات قرابة نسب بين الهمذاني وكُتَّاب أوروبيين، وقرر مقارنة المقامات بنوع أدبي آخر مُغاير هو «الرواية التشرُّدية». هل تصح مقارنة كهذه؟ في إطار الترجمة الثقافية، كل المقارنات صحيحة وخاطئة في آن. تصح المقارنة في إطار تقريب مفهوم لجمهور آخر غير معني بالأساس بهذا المفهوم، ولكن في إطار إيجاد مقاربة مُثلى للنوع الأدبي، تصبح كل المقارنات خاطئة، ففي النهاية «المقامة» بمعناها في الثقافة العربية، ليست هي «الرواية التشرُّدية» في معناها الأوروبي، الدالان كلاهما يشيران إلى مدلولات مختلفة. صحيح أن من يتحمسون لقابلية الترجمة ينظرون إليها كمؤشر على عقلانية أكثر رفعة للنص، ولكن مع ذلك، فإن كل مكتوب، في لغته وللغته، يحافظ في طياته على جزء لا يمكن ترجمته، قد يكون محدودًا، ولكنه حقيقي. إن استحالة الترجمة بالنسبة لنصٍ ما، هي صيغة أولى من صيغ تأكيد الذات، كما يبدو واضحًا في حالة ترجمة الشعر مثلًا، والتي –كما يعرض كيليطو- كان الجاحظ يرفضها بشدة.
لماذا لم يقع عبد الفتاح كيليطو عند ترجمته إلى العربية في مأزق كهذا؟ سؤال كهذا ربما لن يطرحه القارئ لكتاب كيليطو على نفسه، والذي كانت أعماله غالبًا ما تصدر باللغتين -الفرنسية والعربية- في آن، يُدوِّنها كيليطو بالفرنسية، ثم تخضع بعدها للترجمة بواسطة أخرين، مع هذا لم يخش كيليطو من تبدُّل المعنى وانزياحه في اللغة الأخرى عما كان يقصد. لماذا؟ ولماذا لا يمكننا اعتبار كيليطو أوروبيًا لأنه يكتب بلغةٍ أوروبية، رغم أن كيليطو نفسه اعتبر المنفلوطي أوروبيًا رغم أنه يكتب بالعربية؟
لن يطرح قارئ كيليطو هذا السؤال لأن كيليطو ببساطة لم يغادر اللغة العربية، وكان يكتب وهو مُقيم فيها. لا يصلح لفظ «ترجمة» عما كان يحدث مع كتب كيليطو، الأدق لو قلنا «أُعيدت إلى العربية» أو «تمت استعادته». لم يغادر كيليطو سياقه العربي حتى وهو يكتب بالفرنسية، لا يتعلق الأمر بالتحيُّز إلى الثقافة العربية من قريب أو بعيد، فنحن نلمح بين سطور كيليطو ما يشي أحيانًا بعكس هذا التحيُّز المُفترض، بل يتعلق الأمر في رأيي بالموقع الذي اتخذه الكاتب، موقع «نحن» في مقابل «هم». رغم اعتراف كيليطو بخطورة الوقوع في فخ هذه الرؤية الثنائية، إلا أنه مارسها في الكتابة، وإن بذهنية مختلفة، ذهنية تتجاوز شراسة الصراع بين الثنائيات إلى محاولة بناء الجسور.
حين يفحص كيليطو هذه الثنائية سيختار ثلاثة من الرحَّالة كي يُحلِّل، من خلال مدوناتهم، علاقة «نحن» بـ«هم». ولاختياراته في هذا الجانب دلالتها العميقة، دلالة تتجاوز الاسم وصولًا إلى ما يمثله. يختار كيليطو الرحَّالة ابن بطوطة، ومحمد الصفار، والشاعر والأديب أحمد فارس الشدياق. وكلٌ منهم حالة مختلفة تمثل وجهًا مختلف من وجوه رؤيتنا للآخر.
حين يفحص كيليطو حالة ابن بطوطة، يبدو وكأنه يصف مسيرة ارتحال صوفي من مقام إلى آخر. وقد يكون في هذا بعض الصحة. فابن بطوطة انتهى إلى النقطة التي بدأ منها. اكتملت الدائرة، وأخذ الارتحال في المكان بُعدًا آخر يطابقه مع الارتحال في الذات، ما أسماه كيليطو بـ «الصراع بين الحركة والسكون». ثمة تغيرات تحدث للمرتحل أثناء حركته، وتبدو هذه الحركة ذاتها كأنها سعي إلى السكون. وعندما يصل المرتحل داخل ذاته إلى أقصى نقطة ممكنة، يكتشف أنها نفسها نقطة البدء، النقطة التي بدأ منها، وكأن لا مهرب من العودة من جديد. ويكتشف في الوقت نفسه أنه صار يرى موضعه (القديم/ الجديد) لا كما كان يراه من قبل، بل كما يراه الآن، في لحظة الوصول. يشير كيليطو إلى أن ابن بطوطة لم يُدوِّن رحلته إلا حينما عاد إلى بلاده، أي إلى نقطة البدء. هل كان يقصد هذا المعنى؟
بالمقارنة بحالة محمد الصفار، فإن حالة ابن بطوطة أكثر منطقية وقابلية للتصديق. فالصفار كان مبعوثًا في رحلة إلى بلاد لا يعرف لغتها، لم يكن يعرف الفرنسية حين جاء إلى فرنسا. ولسببٍ ما يمكننا أن نفترض أنه لم يكن يعرف لغتها أيضًا حين غادرها عائدًا.
في تحليل كيليطو، فإن محمد الصفار لم ينفذ إلى عمق ما شاهده، واكتفى بالذهول أمام الصورة. الذهنية التي حكمت الصفار في تأويله لمشاهداته هي الذهنية الرافضة ولكن المنبهرة مع ذلك، ولهذا فلم يتعاط بشكل عقلاني مع البلد الآخر، ولهذا ربما لم يسع لتعلُّم اللغة الأخرى.
يصف الصفار في كتابه المشاعر التي انتابته حين رأى تمثال المسيح المصلوب بالصدمة، صدمة المُعتَقد من ناحية، وصدمة المنظر من ناحية أخرى. لم يفطن الصفار لأول وهلة إلى أن ما يراه تمثال، وظنه «صاحب جناية علّقوه». ويسهب الصفار في الحديث عن إتقان صناعة التمثال، في اللحظة التي يعلن فيها فساد المُعتقد وراء تلك الصناعة. يمكننا سحب هذه الرؤية على تحليل رحلة الصفار، شاهد الصفار التمثال وانبهر به، لكنه كان رافضًا لما وراءه بصورة بدئية.
سنلمح الصدق في كل من الموقفين اللذين اتخذاهما ابن بطوطة والصفار وإن كان بصور متقابلة. رغبة الأول في الفهم، قابلها قرار الثاني بالرفض المبدئي. يمكننا في النهاية استيعاب موقف هذا وموقف ذاك. ولكن موقف أحمد فارس الشدياق يختلف جذريًا عن هذا وذاك. يُحسب للشدياق بالطبع شجاعته في عرض صورة الذات بكل مشاكلها وعيوبها فيما دوَّنه. ولكن الشدياق دخل إلى حضرة هذا الآخر مُحمَّلًا بما يتوهمه من أمجاد قومه وأهله، مُتخيِّلًا أنها كافية وحدها لإبهار الآخر. ولعل اسم الكتاب في حد ذاته -«الساق على الساق فيما هو الفارياق»- قد يمثل إشارة إلى الوضعية المتعالية التي اتخذها الشدياق في استقباله لهذا المجهول.
ظن الفارياق أنه قادر على اجتذاب السادة الأوروبيين إليه من خلال ما يجتذب به السادة عادة في بلاده، كان الفارياق يقرض الشعر ويَنظمه، وسبق له أن مدح والي تونس، ونال عطية منه بالشعر، ولكن هل كان يظن أنه يستطيع نيل عطية الملكة فيكتوريا أو نابليون بقصائد المدح؟ أحال الفارياق إذن سياقه على سياق الآخر، مُتصوِّرًا قابلية هذه الإحالة إلى التطبيق، ومُنزِّهًا سياقه هذا عن ألا يكون هو الحقيقة الوحيدة، القابلة للتصديق.
يركز كيليطو خلال تناوله لسيرة الفارياق على مسلسل إخفاقاته مع السادة الذي طلب ودّهم في أوروبا. تشي طريقة تعامل الفارياق نفسه مع تلك الإخفاقات بنوعٍ من الكلبية، فقد انتظر لسنوات تلقي رد الملكة في انجلترا على قصيدته ولم ينل شيئًا، وكان أقصى ما حصل عليه من نابليون في فرنسا هو رسالة شكر مبعوثة من كاتب السلطان، ورغم هذا لم ييأس الفارياق وبعث بقصيدة أخرى إلى نابليون عند توليته إمبراطورًا. وإن اختلفت هذه عن سابقتها في ملمح رئيسي يراه كيليطو دالًا وهامًا.
تختلف القصيدة الثانية عن الأولى اختلافًا يعزوه كيليطو إلى تغيُّر الموقف تجاه هذا الآخر؛ سيضطر الشدياق إلى التخلِّي عن المقدمة الغزلية في قصيدته الثانية -بخلاف ما درج عليه الشعراء العرب في قصائدهم من بدء قصائدهم بالغزل في الأنثى- كي يقترب خطوة من نفس ممدوحه نابليون، بعد أن قُوبِلتْ قصيدته الأولى بالتجاهل، والتجاهل في عرف الشدياق هو عدم نيل العطيّة. سيضطر -كما يقول كيليطو- إلى الإخلال بنظام القصيدة المألوف، وجحد حق الأنثى في تصدُّر القصيدة. سيضطر إلى إجراء عملية بتر وإخصاء لشعره، كي يصل إلى الذوق الأوروبي.
القصيدة التي كتبها الشدياق لم تصل لنابليون كما أراد لها صاحبها، بل عبرت أولًا -عن طريق مترجمها- من لغتها إلى اللغة الأخرى، من الفرنسية إلى العربية، من سياقٍ كانت كفيلة فيه بمنح صاحبها عطيّة مجزية، إلى سياقٍ آخر لم تكفل فيه لصاحبها أكثر من قصاصة ورق تحتوي على عبارتين من الشكر.
لم يكن الشدياق يجهل هذا التفاوت بين الأدب العربي والأدب الأوروبي الذي كان مطلعًا عليه، لكنه كما يروي لم يستطع مقاومة الرغبة في تقديمها إلى نابليون.
في تجربته، سيقع الشدياق على أكبر صدمة له، حين يكتشف أن الأدب العربي الذي نشأ وتربى عليه، هذا الذي يشكل عالمه المألوف، لا ينسجم مع الذوق الأوروبي. وسيبدأ تلقائيًا في اتخاذ موقف الدفاع أمام صدمة الهجوم. رفض قصيدته لا يعني رفضًا لشخصه تحديدًا، وإنما يعني رفض الشعر العربي كله، لهذا فإن أوروبا لا تملك شعرًا، ولا تكرم شعراءها،«"فما من أحد من شعراء الإفرنج استحق أن يكون نديمًا لملكه. وغاية ما يصلون إليه من السعادة والحظوة هو أن يرخّص لهم بإنشاد شعرهم في بعض الملاهي». نعم، بالتأكيد فإن العرب أكثر جودًا وكرمًا، وبالتالي فهم أعلى منزلة في الشعر. لم يكن المُنتظر من الشدياق أن يتخلى عن ماضيه ويتنكر لقيمته على كل حال، ففي هذا شيء من التنكر لذاته نفسها.
يبدأ كيليطو أخر فصول كتابه بالاعتراف بأنه لا يحب أن يتكلم الأجانب لغته، ويحيل هذا الشعور إلى الرغبة في حماية اللسان من تطاول الغرباء عليه. لا تتسق هذه المفارقة بالطبع مع من يتحدث لغته بنطقٍ ملتو، ينطق حروفًا مبعثرة وجمل مفككة شاذة، بل مع الغريب الذي يتحدث العربية كأهلها. سينشأ هنا شعور بالارتياب، بأن هذا الغريب يسلبنا لغتنا وينتزع منا لساننا ومقومات وجودنا، يسلبنا مأوانا.
ربما وقع كيليطو ذاته فريسة لإشكالية الترجمة، وظلّ معلقًا بين لغتين. العربية من ناحية كفضاء نشأ فيه وتعمَّق في تراثه، وتشكلت أفكاره داخله، والفرنسية من ناحية أخرى كأداة اختار التحليل والكتابة من خلالها. لماذا اختار كيليطو الفرنسية لغة للبحث في موضوعات تتصل أساسًا بالثقافة العربية؟ هل بدت له أكثر تطورًا وقدرة بحثية من مقابلتها العربية؟ بالطبع لا، ولا شك في إجادة صاحب «لسان آدم» للعربية، لكنه فيما يبدو لم يكن ليراها بهذا الوضوح سوى من ضفاف أخرى. ضفاف لا تتكلم لغته.
لن تتكلم لغتي
عبد الفتاح كيليطو
دار الطليعة
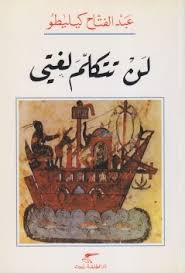

رد واحد على “لن تتكلم لغة كيليطو”
كيليطو