اقتباسات من كتاب «من الأعماق» لأوسكار وايلد
ترجمة: عبد اللطيف محمد الدمياطي
إصدار مطبعة ومكتبة الدار المصرية - 1967
***
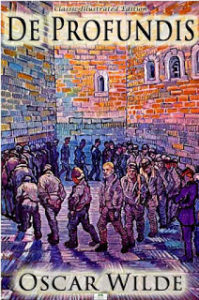
«إن صداقتنا سيئة الحظ والتي يرثى لها إلى أبعد حد قد انتهت بجلب الخراب والفضيحة العلنية عليَّ، ومع ذلك فإن ذكرى مودتنا القديمة لا تزال غالبًا معي. فإذا ما فكرت في أن الاشمئزاز، والمرارة والاحتقار، كل هذا سيأخذ دائمًا ذاك المحل من قلبي الذي كان يحمل الحب شعرت بحزن شديد. وأعتقد أنك تشعر في قلبك بأن كتابتك إليَّ حيث أبقى في وحدة حياة السجن أفضل من أن تنشر خطاباتي بغير إذني أو تهدي إليَّ قصائد بغير أن يؤخذ رأيي، وإن كان الناس لن يعلموا شيئًا عن الكلمات التي تبعث بها إليَّ في ردك أو استشهادك، أهي كلمات حزن أو انفعال أو تبكيت أو عدم اهتمام».
***
«إن أعظم الرذائل هي ضحالة العقل».
***
«كنت أفكر دائمًا أن الاستسلام لك في الأشياء الصغيرة لا يعني شيئًا. فحينما تأتي اللحظة الكبيرة سيكون في مقدرتي أن أعيد تثبيت قوة إرادتي في عليائها الطبيعية. غير أن الأمر لم يكن كذلك، فحينما جاءت اللحظة الكبيرة رأيت قوة إرادتي تخونني بصورة تامة. والحقيقة أنه لا توجد في الحياة أشياء صغيرة وأخرى كبيرة، فكل الأشياء في الواقع متساوية في قيمتها وفي جرمها».
***
«إن ذكرى صداقتنا هي الظل الذي يتابعني هنا (في السجن)، والذي يبدو أنه لا يتركني قط. فهو يوقظني في الليل ليخبرني نفس القصة، ثم يعيدها عليّ ويعيدها حتى يهجرني النوم بفعل تكرارها الممل وهكذا حتى مطلع الفجر. وعند الفجر يبدأ ثانية. وهو يتبعني إلى فناء السجن ويجعلني أكلم نفسي بينما أنا أدور حول المكان وكل شيء من التفاصيل التي حدثت في كل لحظة مخيفة أرى نفسي مقسرًا على تذكره. وكل شيء حدث في تلك السنوات المنحوسة لا أستطيع إحياءه في ذلك الجزء من مخي الذي خُصص للحزن واليأس. إن كل نبرة متوترة من صوتك، وكل حركة عصبية من يديك، وكل كلمة مُرة، وكل كلمة مسمومة - كل ذلك يعاودني باستمرار. إنني أتذكر الطريق أو النهر الذي سرنا بجانبه، والحائط أو الحرج الذي اكتنفنا، كما أتذكر الأرقام التي وقفت عليها عقارب الساعة، والاتجاه الذي انطلقت فيه الرياح، وماذا كان شكل القمر، وماذا كان لونه».
***
«لقد كنت عدوِّي، وكنت عدوَّا لم يره قط إنسان. فقد أعطيتك حياتي فطرحتها جانبًا لكي تشبع في نفسك أحط الغرائز وأحقرها، وهي البغض، والغرور، والجشع. وفي أقل من ثلاث سنوات كنت حطمتني تمامًا من جميع النواحي. أما من جانبي فإنه لم يكن لي غرض سوى أن أحبك. فقد كنت ولا أزال أضرب في صحراء الوجود الجافة؛ وقد علمت أنني لو سمحت لنفسي بأن أشعر نحوك بالبغض لوجدت كل صخرة في هذه الصحراء فقدت ظلها، وكل نخلة جفت، وكل بئر جاءت بدليل على أنها مسمومة من القاع. فهل بدأت الآن تفهم قليلًا؟ هل تشعر بأن مخيلتك بدأت تستيقظ من ذلك السبات الطويل الذي وقعت فيه؟ لقد علمت من قبل ما هو البغض، فهل تدرك ما هو الحب، وما هي طبيعته؟ إن الوقت لم يفت لتعلم شيئًا عن ذلك؛ وإن كنت، لكي أعلمك ما هو الحب، وجب أن أدخل زنزانة متهم!»
***
«إن العذاب لحظة طويلة واحدة لا يمكن تقسيمها إلى فصول. وإنما نستطيع فقط أن نسجل نوباتها، ونؤرخ تكرارها. والزمن لا يتقدم بالنسبة إلينا، بل يدور. وهو يبدو كما لو كان يدور حول مركز للألم».
***
«ونهاية هذا كله إنني قررت أن أصفح عنك. بلى، يجب أن أفعل. فأنا لم أكتب هذا الخطاب لأزرع البغض في قلبك، بل لأزيل ما علق منه بقلبي. وإني إذ أصفح عنك إنما أفعل ذلك إكرامًا لنفسي. فالمرء لا يستطيع أن يحتفظ بأفعى في صدره لتعيش على عض جسده؛ وهو لا يستطيع أن يهبَّ كل ليلة ليزرع الأشواك في حديقة نفسه. ولن يكون من العسير عليَّ قط أن أفعل ذلك إذا ساعدتني قليلًا».
***
«إن الآلهة تبدو غريبة التصرف، إذ أنها تعاقبنا على ما هو فينا من خيِّر وإنساني بقدر ما تعاقبنا على ما هو فينا من شر وانحراف، أقول إنني يجب أن أقبل هذا الواقع، وهو أن الإنسان يُعاقب على ما يفعله من خير، كما يُعاقب على ما يفعله من شر. وليس لديَّ شك في أن هذا وضع صحيح بالنسبة إلى كل الناس. فهو يساعد المرء، أو ربما ساعده مستقبلًا، على إدراك الأمرين، فلا يذهب بعيدًا في انخداعه في أيهما، فإذا تسنى لي حينئذ ألا أشعر بشيء من الخجل لما حل بي من عقاب، وهو ما أرجوه، فإنني سأكون قادرًا على أن أفكر وأمشي، وأعيش في حرية».
***
«البؤساء من اللصوص والمنبوذين الذين سُجنوا هنا معي أسعد مني حظًا من نواحي عديدة. وذلك لأن الطريق الضيق الذي شاهد خطيئتهم في المدينة القاتمة أو الحقل الأخضر ليس طويلًا. فهم لا يحتاجون إلى الذهاب أبعد مما يقطعه طائر من وقت الشفق حتى طلوع الفجر ليكونوا بين مَن لا يعرفون شيئًا عما فعلوه. أما بالنسبة إليَّ فإن العالم (قد انكمش إلى عرض الكف)، وحيثما انقلب فإن اسمي يبدو مكتوبًا على الصخور بمداد من رصاص. وذلك لأنني قد جئت لا من ظلمة سوء السمعة العارض في جريمة بل من ضرب من الشهرة الخالدة إلى ضرب من الفضيحة الخالدة! وأنه يبدو لي أحيانًا أنني أظهرت ما كان حقًا يتطلب الإظهار، وهو أن الفرق بين الذائع الصيت والسيء السمعة لا يعدو خطوة، إذا كان حقًا بمثل هذا القدر من الاتساع».
***
«من المحزن ألا يكون هناك إلا القليل ممن استطاعوا قط أن (يملكوا أرواحهم) قبل أن يموتوا! يقول (إيمرسون): (ليس هناك ما هو أندر في الإنسان من فِعل جاء من ذاته هو). وهذا صحيح تمامًا. فأكثر الناس آخرون بالنسبة إلى أنفسهم. فأفكارهم من آراء غيرهم، وحياتهم محاكاة، وعواطفهم اقتباسات».
***
«ليس هناك من هو جدير بالحب. أما الحقيقة القائلة بأن الله يحب الإنسان فإنها تدل على أنه، في النظام القدسي للأشياء المثالية، كتب أن يمنح الحب الخالد لمن لا يستحقه في خلود. فإن بدت هذه العبارة أشد مرارة مما تحتمل فدعني أقول إن كل واحد مستحق للحب إلا ذلك الذي يعتقد أنه يستحقه. إن الحب ضرب من التقديس فيجب أن يتلقاه المرء راكعًا، وأن يتلقاه بينما تعمر قلبه هذه الكلمات وتضطرب بها شفتاه: (يا إلهي! لست مستحقًا). أود لك أن تفكر أحيانًا في ذلك. فأنت أشد حاجة إلى مثل هذا التفكير».
***
«الآليون من الناس، أولئك الذين ينظرون إلى الحياة على أنها تأمل ذكي يعتمد على حساب دقيق للطرق والوسائل، هؤلاء يعلمون دائمًا أين يذهبون، ويذهبون فعلًا إلى حيث يريدون. إن الواحد منهم يبدأ راغبًا في أن يكون شماسًا في كنيسة؛ وأينما طوحت به المقادير فهو ينجح في أن يكون شماسًا في كنيسة، ولا شيء أكثر، فالشخص الذي يرغب في أن يكون شيئًا ما منفصلًا عن ذاته، كأن يكون عضوًا في البرلمان، أو بدَّالًا ناجحًا، أو محاميًا لامعًا، أو قاضيًا، أو أي شيء لا يقل إملالًا، هذا الشخص ينجح بصورة لا متغيرة في أن يكون ما أراد. فأولئك الذين يريدون قناعًا يجب أن يرتدوه. غير أن الأمر يختلف مع القوى المحركة للحياة وأولئك الذين تجسدت فيهم هذه القوى. فالأشخاص الذين انحصرت رغبتهم في تمييز أنفسهم لا يعرفون أبدًا إلى أين يذهبون. إنهم لا يستطيعون أن يعرفوا ذلك. في واحد من معاني الكلمة من الضروري، بالطبع، أن يعرف المرء نفسه، كما قال وحي الإغريق. غير أن هذا هو الإنجاز الأول من المعرفة. أما الإنجاز النهائي من الحكمة فهو أن يدرك الإنسان أن نفسه لا يمكن أن تُدرك. فالسر النهائي هو النفس الإنسانية. ولا عجب، فعندما وضع الإنسان الشمس في كفة الميزان، وقاس خطى القمر، ووضع خريطة لنجوم السماوات السبع نجمًا بعد آخر، بقيت نفسه بعيدة عن هذا المنال. فمنذا الذي لا يستطيع أن يضع حسابًا لمدار نفسه؟»
***
«كل شيء عن مأساتي كان بشعًا، سافلًا، منفرًا، ناقصًا في الأسلوب. فحتى ملابسنا نفسها تجعل منا أشياء مضحكة. فنحن بهاليل الحزن، ونحن مضحكون تحطمت قلوبهم، ونحن قد صُنعنا خصيصًا لنكون مدعاة إلى السخرية. في الثالث عشر من نوفمبر سنة 1895 جيء بي من لندن إلى هذا السجن. ومن الثانية حتى الثانية والنصف من ذاك اليوم أوقفت على الرصيف الأوسط من ملتقى الخطوط عند (كلافام) بينما كنت أرتدي ملابس المجرمين وأحمل في يدي الحديد، وذلك ليراني العالم! لقد أُخذت من قاعة المستشفى بغير أن يُدلى إليَّ بأي ملاحظة. فكنت في موقفي أعظم ما يمكن أن يثير السخرية. فعندما كان يراني الناس كانوا يستغرقون في الضحك. وكان كل قطار يصل يزيد في عدد المشاهدين. ولم يكن هناك وسيلة أخرى تزيد في سرورهم. وكان ذلك بالطبع قبل أن يعلموا من كنت. فإذا علموا زادوا ضحكًا. هكذا وقفت هناك لمدة نصف ساعة تحت مطر نوفمبر الأغبر، ومن حولي حشد من السفلة يضحك ويتهكم. لقد لبثت طوال عام بعد تلك الحادثة أبكي كل يوم لمدة نصف ساعة وفي نفس الوقت. وقد يبدو لك هذا الأمر كما لو كان ليس في شيء من المأساة. أما بالنسبة إلى من يعيشون في السجن فإن الدموع جزء من تجربة كل يوم. فإذا انقضى يوم بغير بكاء كان يومًا تحجر فيه القلب. فهو ليس باليوم الذي يقضيه المرء بقلب سعيد».
***
«لقد قال الناس عني دائمًا إنني كنت متغاليًا في فرديتي. فأقول إنني يجب الآن أن أكون أكثر تغاليًا. بلي، يجب أن أذهب في الخروج من نفسي أبعد كثيرًا مما كنت قط، وأن أسأل هذا العالم أقل كثيرًا مما سألته قط. والواقع إن ما حل بي من خراب قد جاء لا من التزايد في الفردية بل من الإقلال منها. فقد كان الفعل الوحيد المخزي في حياتي، والذي لا يغتفر، بل وسيبقى مبعثًا للاحتقار، كان أن سمحت لنفسي بأن أقسر على الالتجاء إلى المجتمع للحصول على المساعدة والحماية ضد والدك».
***
«كنت أشمئز من اعتباري شخصًا (نافعًا)، وقد قلت لك إنه لا يوجد فنان يرغب في ذلك أو يرضى بأن يُعامل على أنه شخص نافع؛ وذلك لأن الفنانين، كالفن نفسه، تنعدم منهم المنفعة».
***
«لقد أتيت إليَّ لتتعلم السرور في الحياة والسرور في الفن. ولكن من يدري، فربما كان قد وقع عليَّ الاختيار لأعلمك شيئًا أكثر عجبًا: معنى الحزن، وما فيه من جمال!».
